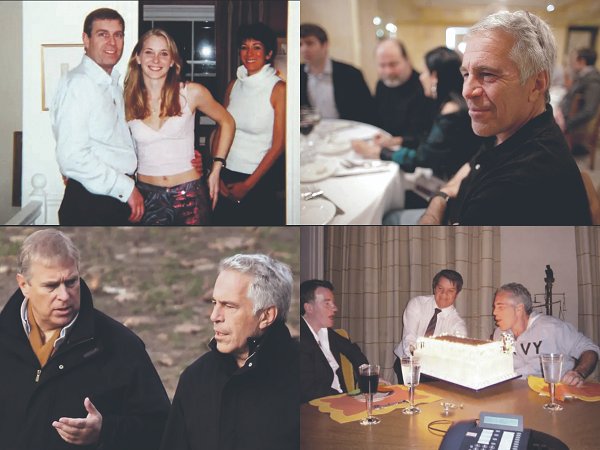أين ذهبت ثروات العائلات الرباطية العريقة؟
من المناصب الاستشارية وحياة الترف إلى الظل

«أين ذهبت ثروة الرباطيين الأوائل؟ بل أين ذهبوا هم أيضا بعد أن فقدت أسماؤهم القديمة بريقها؟ صنعوا تاريخ مدينة الرباط، عاصمة المملكة، ولعبوا دورا كبيرا في حياة المال والأعمال قبل 1912 وبعدها أيضا.
هم أوائل من أسسوا شركات في المغرب، وأسماؤهم العائلية كانت تفتح الأبواب المغلقة، أن يصبحوا نسيا منسيا ويلعب معهم التاريخ لعبته الماكرة و«العريقة». بعضهم عاشوا تجارب مع رجال المخزن ووصلوا إلى قمة السلطة والثراء، ونزلوا بهدوء. وبعضهم خلف نزولهم ضجيجا كبيرا، وتركوا خلفهم الكثير من الغبار..».
يونس جنوحي
+++++++++++++++++++++++++++++
عائلات رباطية طُعن في أصولها الأندلسية
«.. وقد رغب شرفاء آخرون في الانتقال إلى الرباط فسمح لهم السلطان بذلك، وهم المكي بن عبد الله الوزاني وابن عمه الطيب بن أحمد بأولادهما، وضمت المدينة شعبا عديدة من الأشراف، سواء الذين استقروا فيها منذ القديم، أو الذين ظلوا يهاجرون إليها حتى في النصف الثاني من القرن.. وقد لعبوا دورا قريبا من دور العلماء، فعند بيعة السلطان يكونون في مقدمة الأعيان، فيساهمون في تأييد الناس للسلطان المبايع بعد تبريكهم لبيعته».
هذا مقتطف من البحث القيم الذي أنجزه الدكتور عبد الإله الفاسي في ماي سنة 1988، بخصوص أعيان الرباط وممتلكاتهم. يتحدث في هذا المقطع عن السياق التاريخي الذي جعل بعض العائلات ترحل صوب الرباط، للبحث عن حياة أفضل، إلى جانب العائلات الأخرى التي سبقتها إليها.
العائلات العريقة الأولى في الرباط، بحسب روايات كثيرة، وفدت على المدينة من الأندلس بعد ترحيل وطرد العائلات المغربية من إسبانيا. ذكريات محاكم التفتيش الإسبانية الفظيعة، رافقت هؤلاء «الموريسكيين» الذين اختاروا الرباط مقاما لهم، ولم تُمح من ذاكرتهم لقرون بعد أن مرروها إلى أحفادهم.
إلا أن مقالا تاريخيا صدر سنة 2020، وتم تداوله على نطاق واسع، يشكك في الرواية التاريخية، ويطعن في انتماء بعض الأسر الرباطية إلى الأندلس.
على كل حال، فأغلب العائلات المعنية بالموضوع لن يضرها أن يُطعن في انتمائها إلى الأندلس، ما دام انتماؤها إلى الحياة السياسية والاقتصادية المغربية واضحا.
جل هذه العائلات راكمت ثروة كبيرة في المغرب فور استقرار أفرادها في الرباط، واستطاعوا، شأنهم شأن الوافدين على المدينة بعد الحماية، حيازة ثروات خيالية، والتمتع بنفوذ مخزني كبير، نافسوا به الفاسيين الذين طالما اعتبروا الرباطيين ليسوا فقط أبناء عمومة، وإنما منافسين شرسين لهم على النفوذ.
ورثة وزارة الأحباس.. مطبخ نقل الملكيات ومصادرة الثروات
سبق في «الأخبار» أن تناولنا موضوع ملفات وزارة الأحباس المغربية، بعد أن صارت الرباط عاصمة للمملكة.
إذ إن الحماية الفرنسية منذ فرضها سنة 1912، لم تتفصل أبدا في موضوع الشريعة الإسلامية والأحباس، وجعلتها لوحدها اختصاصا للسلطان وحده، يبت في شؤونها وتشريعاتها مع العلماء والقضاة. وهؤلاء كانوا يختارون بعناية الأسماء التي تجلس فوق كرسي وزارة الأحباس، وأحد هؤلاء الذين بصموا وزارة الأحباس، محمد الجاي.
برز محمد الجاي إلى الضوء تقريبا سنة 1909، كواحد من موظفي الدولة وأعيانها أيضا. ورث عن أسرته خدمة دواليب المخزن وتعقيدات الإدارة. إذ كان من بين المتعلمين القلائل الذين يحظون بشرف مرافقة القواد والباشوات الكبار في ذلك الوقت. وكان نصيبه أن يشتغل مع المدني الكلاوي في ديوانه ككاتب خاص، حيث هناك سوف يتعرف على أعيان من طينة أخرى لم يعتد لا هو ولا أسرته أن يخالطوهم. فقد خرج من منطق القبيلة إلى منطق الدولة، وأصبح تلميذا نجيبا في دواوين الوزراء بعد أن أوصله الحاج المدني إلى هرم السلطة، لكي يكون أحد المحسوبين عليه في قلب دار المخزن. وكانت تلك سياسة مألوفة ومفهومة في ذلك الوقت.
بعد ذلك أصبح محمد الجاي صديقا مقربا لبعض أعضاء المجلس الاستشاري، الذي كان يتكون من علماء من جامعة القرويين، بالإضافة إلى قضاة من مختلف مناطق المغرب.
وأصبح الجاي يتردد بكثرة على القصر الملكي، بصفته موظفا مخزنيا في مكتب تقليدي كانت مهمته هي التنسيق مع مكاتب الوزارات. إلى أن أصبح مع وصول المولى يوسف إلى الحكم سنة 1912، واحدا من كبار موظفي القصر الملكي، وتم ترشيحه بقوة ليصبح في لائحة وزراء السلطان.
وهكذا مُنحت له، بدعم من الحاج المدني، وزارة الأحباس. إذ إن الحاج كان يدافع عن الأسماء التي اقترحها سابقا، وكان المولى يوسف ينصت جيدا لمستشاريه المقربين، بينما كان الحاج المدني يمثل سلطة القبائل التي تكون لها كلمة مسموعة في القرارات السيادية للدولة.
آلت وزارة الأحباس إلى محمد الجاي، وأصبح الوزير الذي بدأ كاتبا في الدواوين، يتحكم في الأملاك المخزنية.
التحكم في الأملاك المخزنية يعني شيئا واحدا، أن الرجل عاش مآسي بعض العائلات التي صودرت ممتلكاتها، ووثق حيازة تلك الممتلكات أو عودتها إلى ملك الدولة. فأغلب الثروات المصادرة والعقارات كان أصحابها قد راكموها في ظروف غامضة، أو بالسطو على ممتلكات الغير، وجلها آل في الأخير إلى الأحباس المخزنية، خصوصا في المدن.
كانت وزارة الاحباس في عهد المولى يوسف مُسيطرا عليها من طرف صديق طفولته الذي درس معه في عهد المولى الحسن الأول، واسمه امحمد اعبابو. في سنة 1912، أصبح اعبابو متحدثا باسم القصر الملكي، بشكل غير رسمي. وكان قد حاز أملاك مخزنية كثيرة في عهد المولى يوسف، وتولى محمد الجاي تفويتها بأمر من اعبابو إلى عدد من الشخصيات التي كانت على علاقة بصديق القصر. لكن هذا لا يعني أن الجاي كان من الطبقة المخزنية الفاسدة، فالرجل كان خريج مدرسة مخزنية صارمة كلفته منصبه خلال أيام المولى يوسف، ولم يثبت أنه حاز أي ثروة في عهد المولى يوسف، أو أنه ضاعف رصيد أسرته، رغم أنه كان على رأس وزارة الأحباس التي كانت من أغنى الوزارات.
«أمراء الحج».. أثرياء عُينوا لمرافقة أفراد العائلة الملكية إلى مكة
كان المفكر المغربي والمؤرخ، عبد الله العروي، أحد أوائل الذين أصلوا لتاريخ بعض أعيان الرباط وبنية المجتمع الرباطي.
تشير بعض المصادر التاريخية، أهمها «مدينة الرباط وأعيانها في القرن التاسع عشر»، إلى ظاهرة «أمراء الحج» الرباطيين: «كانت ظروف الانفتاح قد أملت على السلطان أن يساعد عددا من التجار المغاربة برؤوس الأموال، وأن يمنحهم حق القيام بالتصدير والاستيراد. وفي الواقع، كانت هذه الفئة من الناس، التي سُميت بتجار السلطان موجودة منذ عهد السلطان محمد بن عبد الله. وفي زمن المولى عبد الرحمن، تكونت من مسلمين ويهود تاجروا في تلمسان وتمبوكتو ومصر، وكان نجاح العمليات التجارية يجعل التاجر يشرك أعضاء من عائلته، سواء إخوته أو أبناءه، فيستقرون في هذه المدن.
وفي كثير من الأحيان، يعين مثل هؤلاء التجار أمراء الحج. وقد يتكلفون بمصاحبة الأمراء وأعضاء من العائلة السلطانية، وبرعايتهم. فإذا نالوا ثقة السلطان فهو يمنحهم المال لاستثماره في التجارة. وقد قام هؤلاء التجار بتصدير الحبوب والماشية إلى جبل طارق، حيث كان يقيم وكيل المغاربة، وهو شبه قنصل مغربي يرعى مصالح التجار هناك. وكان تاجر السلطان يستفيد من احتكارات المخزن، ومن القروض، ويوسع عليه في دفع ما عليه من الديون كما ستأتي به الأمثلة، كان السلطان يحدد نسبة الأرباح بـ20 في المائة على العموم، وفي حال نجاح تاجر السلطان يصبح من ذوي الأموال، وقد يلتجئ إليه المخزن ليقرض بيت المال».
هؤلاء الرباطيون امتدوا في المناصب إلى حدود سنة 1912، وصار أبناؤهم بعدهم من أعيان مدينة الرباط.
فمثل أسرة فرج، والجراري، وكلها أسر جاءت إلى الرباط من مناطق أخرى من المغرب، استطاع أبناؤها فعلا توارث المناصب المخزنية، والحفاظ على ثقة سلاطين الدولة العلوية.
حتى أن بعض هؤلاء الموظفين المخزنيين كان يُعهد إليهم بمهام من قبيل تدريس أبناء السلطان والوزراء، وتقديم خدمات استشارية، سيما في ما يتعلق بجمع الضرائب، والقضاء.
هؤلاء، كانوا يقترحون الأسماء التي سوف تتقلد المناصب المهمة، خصوصا في سلك القضاء، وهو ما يفسر عداوة «أهل فاس» معهم، على إثر اتهامهم لهم بأنهم وراء إقصائهم من الوصول إلى المناصب المخزنية في الرباط، عندما انتقلت إليها السلطة من فاس.
العائلات الرباطية العريقة لم تكن كلها مولعة بالمناصب المخزنية، فبعض أبنائها زهدوا فعلا في المناصب وركزوا اهتمامهم على التجارة والمال والأعمال، سيما بعد انتشار ظاهرة افتتاح شركات ثنائية بين المغاربة والإنجليز، واتخذت من رصيف ميناء سلا مقرا لها. هؤلاء التجار الذين ركزوا لبناء ثروتهم على الاستيراد والتصدير، وصل أبناؤهم لاحقا إلى المناصب المخزنية، بعد أن نجح آباؤهم في بناء إمبراطوريات مالية، جعلت أسماءهم تطغى على سماء الرباط.
لكن ما وقع لعدد من العائلات الرباطية يبقى تراجيديا، إذ إن مشاكل السلطة أثرت على ثروتهم، ونزلوا إلى القاع، وهناك عائلات سُلبت منها ممتلكاتها، وأصبح أفرادها شبه متشردين بعد أن كان اسمها على لسان كل الرباطيين.
الحصيني وبريطل وبرگاش.. رباطيون أقرضوا الدولة واستغلوا أزماتها
«من أبرز هؤلاء التجار الرباطيين الكبار، بوعبيد الحصيني الرباطي والمكي بريطل الذي كان له في جبل طارق وكيله وأحد أفراد عائلته، وهو الهاشمي بريطل، يرسل إليه ويستقبل منه السلع.
وكان هؤلاء التجار يستغلون أوقات الأزمات لتحقيق الثروات، ففي سنة 1851 عندما كانت البلاد تعيش مجاعة، أرسل الهاشمي بريطل إلى شريكه المكي بريطل 1178 فانيكة من القمح في 7 مارس 1851، ويمكن التكهن بالربح إذا عرفنا ما بلغته الأثمان من ارتفاع، نتيجة ندرة الحبوب.
وكان للمكي بريطل شريك آخر هو أحمد بريطل، وقد كلفه بأن يحمل له عبر سفينة «كورو روز» ستة أكياس تضم 6000 قطعة من قطع خمسة فرنكات إلى جبل طارق.
ومن هؤلاء التجار أيضا محمد بن عبد الرحمن برگاش الذي قضى شبابه بجبل طارق ولندن مشتغلا بالتجارة، والحاج بناصر مرسيل الذي سافر إلى جنوة منذ 1829، وكان من رؤساء البحر كما ذكرنا آنفا، ومن اليهود الرباطيين أيضا من ذكرناهم سابقا مثل سلمون بن زكري، ومسعود العسري، وآخرين من الذين حققوا ثروات طائلة».
هذا الاقتباس من البحث الغني الذي صدر في كتاب «مدينة الرباط وأعيانها في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين»، للدكتور عبد الإله الفاسي، وهو يرصد أسماء بعض العائلات الرباطية وقصة صعودها.
لكن المثير، تأمل نهايات بعض هذه الأسر. فالعائلات الرباطية، مسلمين ويهود، التي أشار إليها الكتاب أعلاه، لم تحتفظ بعضها بعلاقات وطيدة مع المخزن، والسبب دخول أبنائها في بعض الصفقات المشبوهة مع دول أجنبية، بمساعدة بعض السماسرة، واستغلال صفتهم التجارية التي يزكيها المخزن، لتحقيق مآرب شخصية.
فالأسر التي بدأت علاقات تجارية مع شركات أجنبية، سرعان ما فكر أبناؤها في الاستقرار بأوروبا، خصوصا مارسيليا في فرنسا ومانشستر في بريطانيا.
هذا الاستقرار جعلهم يربطون علاقات وطيدة مع تجار أوروبا ورجال الأعمال هناك، وتعلموا منهم حيل التهرب الضريبي، ومنهم من استغل علاقاته في المغرب لكي يتحدث باسم الدولة المغربية، مثل ما وقع عندما أوقف المولى عبد الرحمن بن هشام محاولة تاجر يهودي أراد اقتناء أسلحة من إيطاليا، بدعوى أنه يمثل السلطان فيها. وحدث أن راسل الإيطاليون القصر الملكي في فاس، ليتأكدوا ألا علاقة بين المخزن وبين سليل العائلة الرباطية الذي أراد الحصول على صفقة السلاح بتكلفة منخفضة.
بعد سنة 1830، دخل المغرب مرحلة الخطر بسبب احتلال فرنسا للجزائر، وبداية تسرب أخبار إلى المغرب مفادها أن فرنسا تضعه على اللائحة لاحتلاله مباشرة، بعد بسط ثكناتها العسكرية في شرق المغرب. وبالتالي لم يعد مسموحا لعدد من التجار المغاربة الاحتفاظ بعلاقاتهم التجارية. كما أن بداية الوجود الفرنسي في المغرب، أدخلت عائلات جزائرية إلى الرباط، وزاحمت الأسر المغربية كثيرا على السلطة. نتحدث هنا عن عائلات المعمري والمقري وغرنيط والخطيب.
هؤلاء نجحوا فعلا في فرض هيمنة أسماء عائلية جديدة في الرباط، وإتقانهم للغة الفرنسية كان نقطة تميز لهم عن بقية العائلات الرباطية. لكن نهاية بعضهم لم تكن متوقعة.
«الآخرون» الذين سقطوا من التاريخ بعد أن شاركوا في صناعته
من بين الذين اشتغلوا على تاريخ العائلات الرباطية، نجد الباحث المغربي إبراهيم التادلي. هذا الأخير كرس سنوات من حياته لبحث رصين سبر فيه أغوار أحداث سياسية أثرت في المغرب، لكنها انطلقت من الرباط، وغيرت خريطة الأسماء القوية التي تمثله.
يقول إبراهيم التادلي إن عائلات مدينة الرباط كانت تعيش ثراء خياليا، إلى درجة أن بعضها كان يملك بيتا، وأسرة بطبيعة الحال، في كل مدينة كبيرة يفتح فيها محلات تجارية. الأسرة هنا تعني زوجات وليس زوجة واحدة فقط، ومجموعة من الأبناء، بالإضافة إلى العبيد والخدم.
وأعطى التادلي المثال بالحديث عن أسرة الزعيمي في الرباط. هذه الأسرة كانت كثيرة الأبناء، وكل واحد منهم عمل بجد على تنمية ثروته التي ورثها عن الجد الزعيمي، إلى أن أصبحوا يملكون إمبراطورية مالية حقيقية مع نهاية القرن.
حتى أن العائلة أصبحت تنقسم إلى فريقين. فريق يعيش في الرباط ويتزعمه الثري محمد الزعيمي، وفريق آخر يعيش متنقلا بين مدن مغربية كبيرة كمراكش وفاس والدار البيضاء، ويتحكم فيه الأب، أي والد محمد الزعيمي. وكانت هذه الأسرة قد انتقلت مع اقتراب الحماية الفرنسية وحلول القوات العسكرية الفرنسية في الرباط إلى مدينة طنجة، لكي تبدأ في الاستثمار سنة 1911، في ميناء طنجة.
وتركت خلفها ممتلكات في الرباط بينما قامت ببيع أخرى قبل رحيلها، لكن مصير الأسرة بعد الانتقال إلى طنجة بقي مجهولا. وهناك من رجح أن أفرادها هاجروا خارج المغرب بعد الأزمة المالية لسنة 1929 والتي تضرر منها الاقتصاد العالمي كثيرا، وكانت فرصة لانطلاق أثرياء آخرين نحو العالمية.
وكان فندق الحبشي شاهدا على عملية بيع ممتلكات هذه الأسرة، رفقة أسر رباطية أخرى. حيث كان هذا الفندق يتحول إلى مزاد علني بانتظام لبيع ممتلكات الأسر التي دار عليها الزمن دورته، أو الأسر التي كانت ترغب في الانتقال من الرباط، خصوصا خلال الأزمات التي كانت تضرب في عمق المدينة بين الفينة والأخرى.
وهناك اليوم في أرشيف الرسائل المخزنية رسائل من ابن الزعيمي يتحدث فيها باسم الأسرة عن علاقته وبعض إخوته بالمخزن، لتبقى آخر الآثار على مجد الأسر الرباطية «المُختفية».
من بين الأسر الأخرى التي أثرت في تاريخ الرباط، نجد عائلتي بن رشيد وبنخدة. كلا العائلتين وفدتا على الرباط في المرحلة الانتقالية للسلطة، أي بعد سنة 1912، ووجدت لنفسها بسرعة مكانا في ظل المخزن. سيما وأن العائلتين معا كانتا من بين العائلات القليلة التي كافأها المخزن المغربي بتعويضات مهمة عن الممتلكات التي فقدتها في فترة عدم الاستقرار التي تلت وفاة المولى الحسن الأول من 1894 وصولا إلى سنة 1907. إذ إن بعض العائلات المخزنية تضررت كثيرا بسبب ولائها لأحد أبناء المولى الحسن الأول دون الآخرين من أبنائه، في ظل الصراع على السلطة. واضطرت هذه الأسر إلى الرحيل صوب الرباط بعد مبايعة المولى يوسف، وسرعان ما بدأت حياة مالية جديدة بحماية من المخزن لتعويض الخسائر التي تكبدتها في معارك إعادة فرض سيطرة المخزن على مناطق من المغرب، خصوصا تازة ومراكش.
هذه العائلات «سيئة الحظ»، إذ إن مجدها الرباطي لم يستمر طويلا، فبسبب قرب أفرادها من الإقامة العامة الفرنسية واشتغالهم في مشاريع مع الفرنسيين، كانوا أهدافا للحركة الوطنية المغربية، وعوقبوا على قربهم من فرنسا في زمن الحماية، وأصبح عقابهم أشد بعد سنة 1955. ممتلكات هذه العائلات أعيد توزيعها ومنها ما انتقل إلى ملكية الأحباس، سيما العمارات والفيلات العصرية التي كانت من أوائل البنايات الجديدة في الرباط.
عُرف عن هذه العائلات أيضا اهتمامها باقتناء السيارات الفارهة واللوحات الفنية، وكلها ممتلكات تُطرح الآن تساؤلات كثيرة بشأن مصيرها.
قصر المقري يتحول من معلمة فاخرة إلى «عقار مخيف»
عندما نتأمل حال قصر المقري مثلا في الرباط، نُدرك فورا أن نهاية الوزير القوي لم تكن سعيدة.
هذا الثري الذي جاء إلى المغرب موظفا بسيطا أيام دولة المولى يوسف سنة 1912، استطاع أن يصبح الوزير الأكثر نفوذا في المغرب إبان الحماية.
كان يتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة، ولديه صداقات وطيدة مع موظفي الإقامة العامة في الرباط، وسرعان ما أصبح الوزير الأكثر قربا من السلطان مولاي يوسف، ويتحول من موظف في الجزائر إلى وزير برتبة «صدر أعظم» في المغرب.
عندما انتقلت السلطة إلى محمد بن يوسف، حافظ الحاج محمد المقري على موقعه في المخزن. واستقر سياسيا إلى حدود بداية أربعينيات القرن الماضي، عندما بدأت العلاقة تتوتر بين السلطان محمد بن يوسف وبين الإقامة العامة الفرنسية، بسبب قربه من الحركة الوطنية.
وهكذا اختار المقري أن يصطف إلى جانب فرنسا. القشة التي ستقصم هرم سيطرة الحاج المقري داخل مربع المخزن الضيق، موقفه الغامض من قضايا كانت تمس سيادة المغرب، مثل نزع سلطات الملك محمد الخامس، ونفيه خارج المغرب. لم يُبد الحاج المقري أي تضامن مع القصر الملكي، رغم أنه كان يشغل أرفع منصب وزاري في الدولة. وهكذا انتهى سياسيا بمجرد عودة الملك محمد الخامس من منفاه، ليكون الحاج المقري قد جمع حقائبه، لأن اللعبة بالنسبة إليه قد انتهت بمجرد ما علم أنه وقف، في الوقت غير المناسب، في مكان لا يليق بوزير جايل خمسة ملوك علويين.
كان المقري، أيام مجده، أسطورة لأنه كان يرافق الملك الراحل محمد الخامس في كل زياراته وخرجاته، وبنظرته الغامضة ولحيته ونظاراته الطبية، كان يُضفي مزيدا من الغموض على شخصيته، حتى أن الحسن الثاني عندما كان وليا للعهد، كان ينظر إليه بدوره بكثير من التوقير، إلى أن أبان عن ولائه لفرنسا، عندما لم يحرك ساكنا عند نفي الأسرة الملكية خارج المغرب.
صودرت ممتلكاته بعد الاستقلال مباشرة، وتوفي سنة 1957، وكانت إقامته الفاخرة بالرباط، والتي سميت «دار المقري» قد تحولت إلى بناية مهجورة، استغلت في عمليات التعذيب السرية التي عاشها مغاربة سنوات الرصاص، ليصبح اسم المقري مقرونا باللعنة.
وتحول قصر المقري منذ سنة 1963 إلى معتقل سري، أيام ما يعرف الآن بـ«سنوات الجمر والرصاص». إذ حسب شهادات كثيرة لضحايا تلك المرحلة، والذين كانوا من قدماء المقاومة أو من المعارضة السياسية خلال بداية فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني، فقد نزلوا في دار المقري التي تحولت بعد مصادرتها ورحيل المقري عقب صدور اسمه سنة 1955 في لائحة الخونة، إلى مركز سري للتعذيب.
وهكذا أصبح اسم القصر الذي كان مضرب المثل في البذخ والرفاهية، مقرونا بمرحلة سيئة من تاريخ المغرب السياسي.