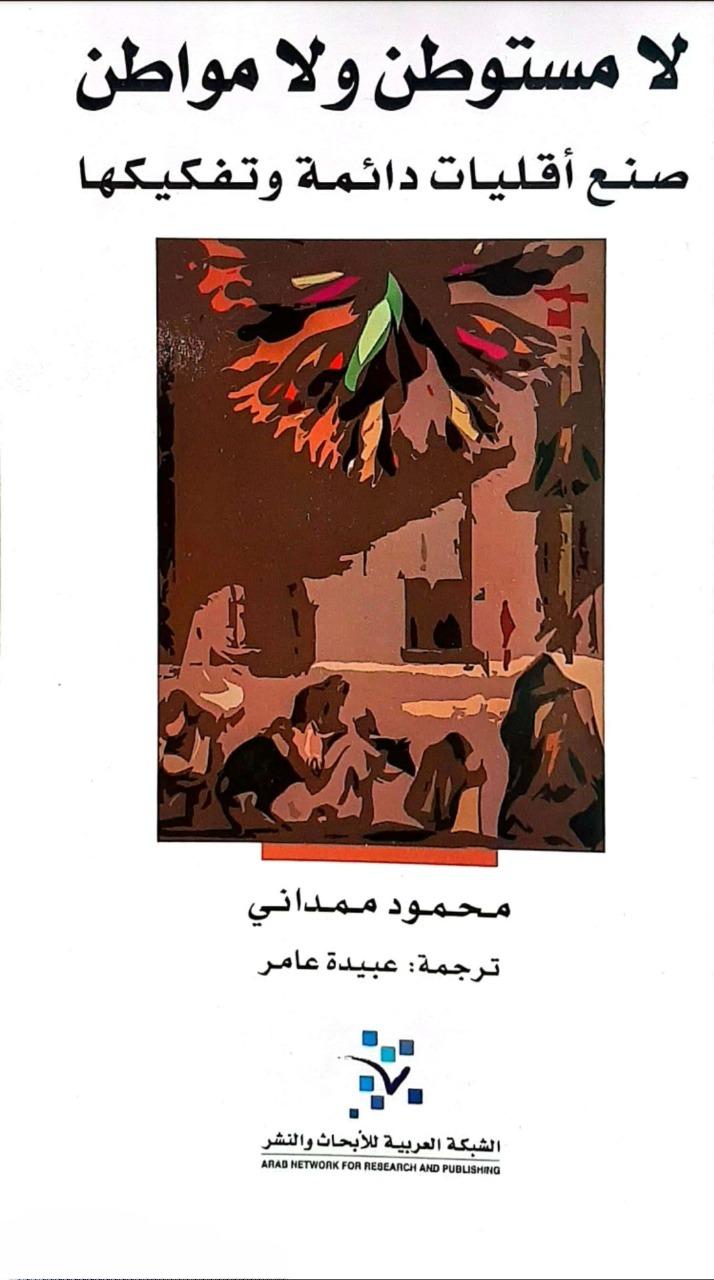إعداد وتقديم: سعيد الباز
حاز الكاتب الفرنسي لوران موفينييه جائزة غونكور لسنة 2025، عن روايته «البيت الفارغ»، بعد توقعات كثيرة بهذا الفوز، بالنظر إلى ما نالته هذه الرواية من حضور متميّز وإقبال لدى القراء وإشادة النقاد، إضافة إلى تفرّد الكاتب بمسار روائي ممتد ومتعدد شكّل من خلاله مشروعا روائيّا متطوّرا على مستوى موضوعاته وأسلوبه الروائي الخاص. واعتبرت روايته الفائزة أبرز مثال عن تجربته الروائية.
لوران موفينييه.. رواية عن طفولتي
حاز الروائي الفرنسي لوران موفينييه Laurent Mauvignier جائزة غونكور لهذه السنة عن روايته «البيت الفارغ» التي شهدت إقبالا كبيرا من لدن القراء.
وكان رئيس أكاديمية غونكور، الكاتب فيليب كلوديل، نوّه أمام الصحافة بمجمل أعمال الكاتب وخصّ روايته الأخيرة بإشادة خاصة، قائلا: «نحن نحيي كاتبًا له أعمال مهمة بالفعل، وقدم لنا هذا العام ليس مجرد عمل، بل رواية أساسية». وعبّر لوران موفينييه، أثناء تسلمه للجائزة، عن سعادته بهذا التتويج: «أنا في غاية السعادة، إنّها مكافأة عظيمة لأنّها رواية عن طفولتي، تمتدّ جذورها عبر أجيال من العائلة والذاكرة».
ولد لوران موفينييه في تور الفرنسية سنة 1967، وحصل سنة 1991 على شهادة تخصّص في الفنون التشكيلية. صدرت له روايته الأولى «بعيدا عنهم» سنة 1999 في منشورات «مينوي» التي صارت الناشر الرئيسي لأعماله. طبعت له ما يزيد عن ثلاث عشرة رواية نال عنها عدّة جوائز مرموقة، من أهمّها روايته «في الحشد» سنة 2006 التي استوحى فيها مأساة ملعب «هيسيل» لكرة القدم في بلجيكا، حيث انهارت تحت ضغط المتفرجين عدّة حواجز حديدية وجدار، ما تسبّب بوقوع تسعة وثلاثين قتيلا وأربعمائة وأربعة وخمسين جريحا، فضلا عن روايته «كانوا بشرا فحسب» وروايته «البيت الفارغ» التي فاز بها على جائزة الغونكور لهذه السنة.
لموفينييه كذلك ثلاث مسرحيات ودراسة نقدية ورحلة إلى نيودلهي وكتاب في التصوير الفوتوغرافيّ وكتاب حوارات. تميّز بكتابة مكثفة تعنى بالصوّر وبالسعي إلى التقاط الصوت الداخلي للشخوص، وصرّح في الكثير من المرّات بقربه الشديد من كتابات الأمريكي الشمالي وليام فولكنر والنمساوي توماس برنهارد.
البيت الفارغ.. رواية الفقد والذاكرة
تدور أحداث رواية «البيت الفارغ» في أحد المنازل القروية في منطقة تورين الفرنسية حيث عاش أسلاف الكاتب لأجيال متعددة. وعن طريق هذا الفضاء الثابت والأجيال المتعاقبة، يتتبع لوران موفينييه تاريخ العائلة من خلال الأحداث الكبرى التي شهدتها فرنسا وأوروبا من حروب وتحولات في القرن العشرين.
عن اختيار الكاتب لموضوع روايته وخلفياته التاريخية والأدبية والظروف المرتبطة به يقول: «أعتقد أن تاريخ عائلتي يشبه تاريخ ملايين الفرنسيين، بما فيه من مناطق ظلّ وجوانب أكثر مجدا» ويضيف: «قلتُ مع نفسي إن قصةَ هذا الكتاب استثنائيةٌ منذ البداية وهي ما تزال متواصلة بشكل لا يُصَدَّقْ ولهذا فوجئتُ بها.
أما بالنسبة لسيرورة كتابة هذه الرواية فهي الأخرى استثنائية وغريبة. فقد وقعت الأشياء من تلقاء نفسها بنوع من السهولة المُحَيِّرة وكتبت فصول الرواية بسهولة ودون تعقيدات. وعندما نُشِرَتْ الرواية كان الاستقبال رائعا من طرف القراء والنقاد ووسائل الإعلام. أنا أكتب وأنشر منذ خمسة وعشرين عاما ولم أعش تجربة كهذه طوال هذه السنوات. وحتى اختيار روايتي من طرف لجنة تحكيم الغونكور في الدور الأول من عملية التصويت كان مفاجأةً بالنسبة لي لأن الروايات الثلاث الأخرى المرشحة ممتازةٌ فعلا وأنا معجبٌ بكُتّابِها. يجب أن أوضح هنا أن كتابةَ هذه الرواية كانت نوعا من العلاج النفسي وأنها أنقذتني حرفيا. ذلك أنني كنت في غاية المرض وأخضعُ للعلاج في المستشفى لشهور طويلة بعد إصابتي بمرض السرطان ومع ذلك واصلتُ الكتابة كلما سمحت لي صحتي الهشة بذلك. كنت أفتح الكمبيوتر كل يوم وأكتب لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة. كان لدي انطباعٌ بأن الرواية تعرف مسارَها جيدا وتكتبُ نفسها بنفسها وهذا بحد ذاته معجزةٌ بالنسبة لي.
عندما تم الإعلان عن فوزي بالجائزة فكرت مباشرة في والدتي لأنها الملهم الرئيسي لهذه الرواية وهي التي سردت عليَّ معظم قصص هذه الرواية رغم أنه ليس لها حضور كشخصية في هذه الرواية. أيضا يجب أن أقر بأن الصورة التي تسكنني بقوة منذ سن الثامنة هي صورة والدي الذي شاهد بأم عينه والدتَهُ وهي تخضع بالقوة لحلق رأسها بالكامل بعد اتهامها بمخالطة الجنود الألمان بعد تحرير فرنسا من النازية عام 1945 وسنه لا يتجاوز السابعة.
هذه الصورة جزء من الأشياء التي جعلتني أصير كاتبا. وأتذكر أن جدتي تعرضت لعملية محو قاسية في تاريخ عائلتي حدَّ أنه تم تشطيُب وجهها في البوم الصور العائلية وحتى ذِكر اسمها كان من المحرمات في الوسط العائلي». رواية «البيت الفارغ» هي، في مجملها وكسائر الأعمال الروائية للوران مونفينييه، كُتبت بمنظور طفل تغلب عليه نظرة الخوف والدهشة، وهذا ما عبّر عنه الكاتب في الكثير من حواراته: «يمكنني القول إنَّه في رواية (البيت الفارغ) كما في الكثير من كتبي الأخرى، كنت أكتب من منظور طفل والمنزل الذي أتحدث عنه يبدو في الواقع أصغر بكثير مما هو عليه في الرواية وعندما كنت صغيرًا، كان يُقلقني أن أرى البالغين وقد نسوا تمامًا الطفل الذي كانوا عليه يومًا لقد كنت مهووسًا بفكرة أنني عندما أكبر، يجب أن أظل على اتصال بذلك الطفل الذي كنتُه أنا أيضًا وقد وفيتُ بوعدي فالرجل الذي أنا عليه اليوم يوجه كلامه إلى ذلك الطفل كما كان الطفل في الماضي، يحدّث الرجل الذي سيصبحه وأخشى أن يمحو الرجل الذي سأكونه أثر الطفل الذي كنتُه، أن يكتسب ثقة البالغين وينسى موطن هشاشته الأولى طفولته، التي كانت أيضًا موطن بصيرته الحادّة تجاه عالم الكبار وكما ذكرت تجربتي في المستشفى في تلك السن والتي جعلت وعيي بالعالم أكثر حدةً وعمقا، ولعبت دورًا أساسيًا في نشأة رغبتي في أن أصبح كاتبًا».
إنّ الرواية، كما يقول الكاتب، «هي بالفعل تأمل في الفقد والذاكرة، ولقد سعى من خلالها إلى الغوص في هشاشة الروابط الإنسانية حين يثقلها التاريخ والحروب، وإلى مساءلة ما تبقى فيها بعد الخراب، فهذا البيت ليس مجرد مكان لعائلة بل مرآة لأوروبا التي خرجت من الحربين مثقلة بالصمت، ولأجيالٍ حاولت أن تواصل العيش رغم الفقد الطويل وكل ما أرادت هي أن أجعل من المأساة العائلية استعارة لزمنٍ خسر بيوته، ولم يجد سوى الذاكرة ملجأ يحتضنه».
تقودنا الرواية إلى أعماق هذا البيت مفتتحة أسراره: «تتسرب الأسرار فينا كما لو كانت قد قيلت منذ الأزل، على ألسنة أولئك الذين جعلوا منها أسراراً في الأصل. وليس الأمر أنهم يخونون أنفسهم فيفشون، من غير قصد، ما أرادوا كتمانه، لا، بل لأنهم ليسوا وحدهم، لهم أصدقاء، وجيران، وأقارب، وأناس يشبهون الظلال، أوكلوا إليهم مهمة البوح، عرضاً وبلا نية ظاهرة، بما هم يتقنون إخفاءه. وهكذا، بعد قرن كامل، ما تزال الإشاعات تدور وتتماوج في طيات الستائر، خلف نوافذ الجيران الذين راكموا أسرار عائلتك، وأتقنوا نقلها إلى الأجيال التي كان يراد لها ألا تعرفها، كما ينتقل غبار الطلع في الهواء، ناشراً في البعد أثره عن موطنه الأول».
كانوا رجالا فحسب.. سؤال الذاكرة التاريخية
تعالج رواية Des hommes أو «كانوا رجالا فحسب» في الترجمة العربية، للروائي رولان موفينييه موضوعا شديد الحساسية بالنسبة للذاكرة الفرنسية المرتبط بحرب التحرير الجزائرية على الخصوص والحقبة الاستعمارية الفرنسية بصفة عامة. لذلك يفتح الكاتب جرحا قديما ما زالت آثاره حاضرة في الذاكرة والوجدان الفرنسي بكلّ ما يحمله من تناقضات بين الاعتراف والنكران، والصمت المريب.
يوضح موفينييه هذا الالتباس بقوله: «كلّما تكلّمنا في فرنسا عن الحرب في الأدب انصبّ الكلام على حرب 1914-1918 أو الحرب العالمية الثانية. لقد كُتبت عن حرب الجزائر روايات جيّدة، قليلة ومتباعدة، ولكنّ المشكلة في اعتقادي هي أنّ مؤلفيها ظلّوا مدفوعين بهاجس تربويّ وحاولوا الإبانة عن العلاقات التاريخية أو الكشف عمّن كانوا هم الأخيار ومن كانوا هم الأشرار (في هذه الحرب).
هذا جهد محمود، ولكن إن نحن عايّنا الشاكلة التي بها عالج السينمائيون الأمريكان الحرب في فيتنام… لاحظنا أنّهم يركّزون أغلب الأحيان على تصوير مجابهة مباشرة للعنف أكثر ممّا على تاريخ الحرب. من ناحيتي، لم يكن هدفي أن أضع رواية في حرب الجزائر للإبانة عن الأخيار والأشرار وإنّما لتصوير البشر في سياق أو موقف معيّن». ويبرز الكاتب، إضافة إلى ذلك، الجانب الشخصي والذاتي في روايته «كانوا رجالا فحسب»: «لقد انتحر والدي وأنا في مقتبل الشباب. وقد لزمتني أعوام حتّى أقول لنفسي إنّه ربّما كانت مشاركته في هذه الحرب (بصفته مجنّدا فرنسيا) وما رآه هناك قد ساهما في دفعه إلى الانتحار. أمضى هناك ثمانية وعشرين شهرا. وما هذا بالأمد الطويل. لقد سمعتُ قصص أشخاص أصيبوا (إثر هذه التجربة) بالجنون. قد يشبه هذا نوعا من موطئ مشترك ولكنّني بحثت عن وسيلة فنية للتعبير عنه».
ويستخلص في النهاية الشعور العام لدى الفرنسيين تجاه هذه الذاكرة المؤلمة: «… أي بإيجاز، شعورنا بأننا كنّا في المعسكر السيّئ. ثم إنّ هذه كانت حربا بلا غاية، حربا معقدة بشدّة، ولأنّ فرنسا خسرت في القرن العشرين حروبا عديدة فقد كانت هذه الحرب هي الحرب الفائضة عن الحدّ، حربنا الصغيرة بالمقارنة مع الحرب العالمية الثانية. الحرب التي أشعرتنا بالعار، وأنا أعتقد أنّ الشعور بالعار هو الأقوى».
من أجواء الرواية وشخصيتها الرئيسية ولحظات انهياره نقرأ: «كانت الساعة قد تخطّت الواحدة إلّا الربع بعد الظهر. فوجئ بأنّ كلّ الأنظار لم تُصوّب إليه وأنّهم لم يستغربوا أنّه أيضا تكبّد عناء الاهتمام بهندامه، ولبس سترة وبنطالا متناسقين، وقميصا أبيض وربطة عنق من الجلد الاصطناعيّ، من ذلك النوع الذي كان يُصنع قبل عشرين سنة ولا يزال بالإمكان العثور عليه في مخازن التنزيلات. سيقولون اليوم إنّ رائحته ليست كريهة جدا. ولن يتهكّموا من انّه أتى ليأكل مجّانا. ولن يتظاهر هو هذه المرة بأنّه وصل فجأة. سيدعونه (شعلة الحطب) كما باتوا يفعلون منذ سنوات، وسيتذكّر بعضهم أنّه، خلف الوسخ ورائحة النبيذ، وخلف مظهره المهمل وهو في الثالثة والستين من العمر، يمتلك اسما حقيقيا. سيتذكرون أنّه، خلف (شعلة الحطب) يمكن العثور على (برنار). سيسمعون شقيقته تناديه باسمه: برنار، ويتذكرون أنّه لم يكن دوما هذا الشخص الذي يتعيّش على الآخرين. سيراقبونه مواربة حتّى لا يثيروا ارتيابه. سيرونه بشعره نفسه، الأصفر والرمادي بفعل التبغ ودخان الحطب، وشاربيه الغليظين المتسخين، والثآليل الشديدة السواد على أنفه. هذا الأنف المجدّر البصليّ المستدير كتفاحة. ثم سيرون عينيه الزرقاوين وبشرته الورديّة والمنتفخة تحت العينين، جسمه العريض الصلب. وهذه المرّة، إذا ما انتبهوا فسيلاحظون أثر المشط على شعره المسرّح إلى الخلف ويخمّنون كلّ الجهد الذي بذله ليبدو نظيفا، حتّى إنّهم قد يقولون إنّه لم يشرب وإنّه لا بأس بمظهره.
رأيناه يركن درّاجته النارية الصغيرة أمام حانة (باتو) مثل كلّ يوم، ثم يعرّج عليها بسرعة قبل أن يعبر الشارع ليأتي إلى هنا، إلى صالة الحفلات للقاء شقيقته (سولانج) بمناسبة احتفالها معنا جميعا، نحن أولاد أعمامها وأشقّائها وأصدقائها، ببلوغها سنّ الستين وإحالتها على التقاعد. ليس في هذه اللحظة بل بعد ذلك بالتأكيد، بعد أن يكون انتهى كلّ شيء وتركنا خلفنا نهار السّبت ذاك وصالة الحفلات خالية إلّا من روائح التبغ البارد والنبيذ وأغطية الموائد الورقية، الممزقة والمتّسخة، وبعد أن يكون الثلج في الخارج، على مساحة المدخل الإسمنتية، قد غطّى آثار أقدام كلّ أولئك الضيوف الذين عادوا إلى بيوتهم ليستعيدوا مذهولين ما حصل ذلك اليوم: إذ ذاك فقط، سأستعيد أنا أيضا كلّ مشهد من مشاهد ذلك اليوم مندهشا من انطباعها كلّها في ذاكرتي بمثل هذا الوضوح.
سأتذكّر أنّه في لحظة تقديم الهدايا نظرتُ إليه، وكان واقفا على مسافة قليلة من الجميع يتلمّس شيئا في جيب سترته. سترة لم أره يوما يرتديها وإن بدت لي مألوفة. أعني أنّني لم أره يوما بسترة كهذه من جلد الأيّل، مبذنة بفرو نلمحه عند مستوى الياقة. كانت عتيقة، وتسنّى لي الوقت لأفكّر أنّها كانت ذات يوم تعود لأحد إخوتهما، هو وسولانج، وأنّ هذا الأخ أعطاه حزمة ملابس قديمة مقابل خدمة صغيرة أو كومة حطب يُدخلها إلى المرأب، أو حتّى بلا أيّ سبب سوى أن يهب أخاه ثيابا لم يعد يريدها. قلتُ ذلك في نفسي وأنا أنظر إليه لأنّ يده اليمنى كانت لا تزال قابعة في جيبه وتبدو كما لو كانت تُمسك أو تحرّك شيئا ما، ربّما علبة سجائر، لكن لم يكن الأمر كذلك قطعا، فقد رأيته يخرج علبة سجائره من جيب بنطاله الخلفيّ ويعيدها إليه.
… ابتسمت سولانج وتكلّمت، وضحكت بدورها، ثمّ كادوا ينسون وجودها وتركوها تتنقّل من مجموعة إلى أخرى، ذلك أنّ مجموعات كانت قد تشكّلت بحسب التوافقات والمعارف، فكان بعضهم ينتقل بين الواحدة والأخرى وبعضهم الآخر يتلافى بالعكس هذه أو تلك. لا أدري هل تفادت الذهاب صوبه عارفة أنّه لم يكن بإمكانها التهرّب من دعوته، وأنا أعلم إلى أيّ حدّ كانت تخشاها، أكثر من خشيتها حضور «البومة» وزوجها، وحضور جان جاك أو ميشلين أو إيفلين وبعض الآخرين، ولكن حضوره، هو «شعلة الحطب» برنار، كان أكثر ما تخشاه. ومرارا لمستُ ارتباكها بسبب شعورها بالذنب عندما كانت تختبئ في المطبخ لكي تتفادى استقباله… وبعد أن يتوقف طويلا في حانة (باتو) يصل أمام بوّابة بيتها صارخا إنّه يحبّها، هي أخته، وإنّه يريد أن يراها ويكلّمها، وإنّ من الضروريّ أن تكلّمه، ضروريّ، ضروريّ كان يقول، ويظل يصرخ ويتحوّل صراخه أحيانا إلى وعيد عندما لا يأتي أحد ولا يُسمع من كلّ المنازل الجديدة المحيطة إلّا صدى الفراغ والصمت. صمت ومنازل فارغة أشبه بالكهوف، كان صوته يبدو وكأنّه يضيع فيها ويتضاءل إلى أن يُمحى ويستسلم».
جائزة غونكور.. أصداء وآراء
ارتبط مسار رواية «البيت الفارغ» للروائي لوران موفينييه بمشهد عام للأدب الفرنسي تميّز بعدة خصوصيات خلال هذه السنة، عبّر عنه الشاعر والمترجم والإعلامي المغربي المقيم في فرنسا محمد الخضيري بقوله: «هيمن في الدخول الأدبي الفرنسي لهذا العام، الذي صدر فيه 484 كتابا، سرديات حول الذات و«روايات» عن عائلات المؤلفين، كل هذا في سرد يقارب التاريخ الحديث من منظار «الذات».
هذا العام تطغى شخصيات الأمهات في أعمال العديد من كبار الكتاب الفرنسيين. ومن الكتب التي تشغل المشهد النقدي، رواية «كولخوز» لإيمانويل كارير التي تجعل شخصيتها الرئيسة والدته، التي رحلت عام 2023، عضوة الأكاديمية الفرنسية هيلين كارير دونكوس. وهي رواية اختيرت ضمن قائمة الأعمال المرشحة لجائزة غونكور، ويعتبر كارير مرشحا ذا حظوظ وافرة للفوز بها. ويستكشف العمل الروائي عبر جدارية سردية تاريخ أوكرانيا وروسيا على مدى أربعة أجيال.
من جانبها، تواصل كاثرين مِييه منجزها الروائي المبني على السيرة الذاتية مع رواية «سيمون إيمونيه» (دار فلاماريون)، التي تستحضر انتحار والدتها، فيما نشرت أميلي نوثومب رواية عن حياة والدتها، وقطيعتها مع محيطها العائلي. بالنسبة إلى جريدة «لاكروا»، فإن لائحة جائزة غونكور لهذا العام اختارت أعمالا وجدت طريقها إلى اهتمام القراء. وضربت، على سبيل المثال، رواية ناتاشا أبانا «ليلة القلب» (دار غاليمار)، التي تتناول ثلاث نساء ضحايا للعنف الأسري.
ومن الأعمال التي حققت حضورا مهما رواية لوران موفينييه «البيت الفارغ»، التي برزت كثيرا، ورواية ماريا بورشيه «الاختلاجة» (دار ستوك). ومن ضمن عشرات الروايات الأولى لكتاب فرنسيين، تميزت رواية دافيد دونوف جيرمان، «الوداع على الوجه» التي تعود إلى زمن جائحة كوفيد.
ومع أن ظاهرة الرواية عن العائلة بدت طاغية في الدخول الأدبي ما دفع إلى انتقادها، إلا أنها جزء من تاريخ أدبي فرنسيّ عريق، وفق ما ذكَّر به مؤرخ الآداب ويليام ماركس، في برنامج «صباحات الثقافة» على أثير إذاعة فرنسا الثقافية، قائلا: «إن الحديث عن الذات، وعن العائلة، ليس بالأمر الجديد إطلاقا في تاريخ الأدب، والأدب الفرنسي تحديدا. إذ إنه منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، تطوّر ما نُسمّيه «الرواية الذاتية». ابتكر سيرج دوبروفسكي هذا المصطلح عام 1977، وكان شائعا جدا. ثم مثّله بعضٌ من ألمع الأسماء في الأدب الفرنسي، مثل آني إرنو، ثم كريستين أنغو وأخيرا إدوارد لوي».
أمّا في قراءته لرواية لوران موفينييه «كانوا رجالا فحسب»، فيتناول المترجم العراقي كاظم جهاد موضوع الذاكرة في مشروعه الروائي: «… لا يطلق موفينييه أحكاما أخلاقية ولا يحاكم أحدا، وهو أبعد من أن يسقط في لغة الشعارات والوعظ، بل يعاين الواقع الحيّ بعين الراصد المُشفق والمتألّم، ويستغور دواخل الشخوص لا في استبطان بسيكولوجيّ تجاوزته الرواية المعاصرة بل من خلال معاينة الأفعال والإيماءات والحركات في أقصى كتابة موضوعيّة او ماديّة ممكنة، وحتّى يكشف بالعمق الكافي عن دوافع الشخوص ومعضلتها النفسية والوجودية، عمد كما في كلّ نصوصه إلى كتابة يمكن أن ننعتها بالشفاهيّة، لا بمعنى كتابة تتبنّى لغة المخاطبة اليوميّة، بل بمعنى كتابة تعكس الكلام الشخصيّ وإيقاعه الفوريّ المتقطع والمتلكئ، كما في مخاطبة المرء نفسه، أي في انعقاد خطابه الداخليّ والانسياب الحارّ والجارف لصوته الحميم، صوت ما قبل الوعي أو صوت الضمير… هذا الانبعاث الجارف للذاكرة التاريخية والفردية يؤسس السارد كامل استعادة التجربة ويزجّ فيها جرحه الخاص، وجرح جيله كلّه.
لا مستوطن ولا مواطن.. صنع أقليات دائمة وتفكيكها
ورد في تقديم كتاب «لا مستوطن ولا مواطن.. صنع أقليات دائمة وتفكيكها» لمحمود ممداني: «هذا الكتاب هو استقصاء عن الحداثة السياسية، بشكليها الاستعماري وما بعد الاستعماري. إنه بحث في جذور العنف المفرط الذي ابتليت به المجتمعات ما بعد الاستعمارية.
يسعى الأكاديمي الأوغندي محمود ممداني، ذو الأصول الهندية، إلى فهم الاستعمار على أنه صناعة لأقليات دائمة وعلى أنه سعي إلى الحفاظ عليها من خلال تسييس الهوية، ما يؤدي إلى العنف السياسي، وأحيانًا إلى العنف المفرط. أما الجانب الآخر، وهو التحرر من الاستعمار، فإنه تفكيك ديمومة هذه الهويات.
يناقش ممداني صناعة الأقليات الدائمة من خلال السرديات التاريخية الموجودة في فصول منفصلة حول الولايات المتحدة والسودان وجنوب أفريقيا وإسرائيل. لكن الكتاب كذلك يقدم ادعاءً معياريًا حول تفكيك هذا الواقع وإلغائه.
يتناول المؤلف، في الفصل الأوّل، كيف أنّ تشكيل الجماعة السياسية الأمريكية تضمّن تطورين اثنين. كان الأول اجتماع المستوطنين معا من أوروبا وأفريقيا، وكان الثاني هو التصنيف القانوني للهنود على أنّهم أجانب بلا حقوق، على الرغم من إقامتهم في الأراضي الأمريكية. محاكمات نورنبرغ واجتثاث النازية هي موضوع الفصل الثاني، فيظهر كيف خلّد الحلفاء تشكيل الدولة/ الأمّة من خلال تجريم النازية بدلا من النظر إليها كحالة لسياسات ذات بعد قومي.
في الفصل الثالث استخدمت المنهجيات السابقة نفسها في جنوب أفريقيا، فالمستعمرون الأوروبيون ناضلوا لقمع التمرد، لكنّهم في النهاية دمجوا الأوطان وسلطة السكان الأصليين والقانون العرفي والرقابة، فكان أوّل الأوطان يسمّى «المحميات». السودان هو موضوع الفصل الرابع، فقد ميّز المسؤولون البريطانيون المستوطن عن الأصلي، ووصفوا العرب بحسب الإثنوغرافية المضمنة في الحداثة الاستعمارية بأنّهم مستوطنون ذوو حضارة، والأفريقيين بأنّهم أصليون بلا حضارة.
في الفصل الخامس، استقى اليهود الإسرائيليون الإلهام من النموذج الأمريكي بتعريف وحكم الهنود، حيث تعتبر إسرائيل العضوية بالأكثرية القومية هي المفتاح للمواطنة الكاملة لا الميلاد ولا الإقامة بالأرض المشتركة. الكتاب في خلاصته عبارة عن دراسة تاريخية للإرث الاستعماري بصفة عامة وفي أفريقيا على وجه الخصوص، مع التركيز على تبعاته السياسية في دول ما بعد الاستعمار.
تتوسع أطروحة الكتاب وتتخذ بعدا عالميا يطرح مسألة العلاقة بين القومية والدولة الحديثة والاستعمار الذي يشكّل جزءا لا ينفصل عن البنية السياسية الحديثة في أوروبا وأمريكا. كما يقدّم نقدا عميقا للاستعمار وآثاره على الهوية والسلطة وصناعة الأقليات.
يقول محمود ممداني، في أحد حواراته، عن مجمل أعماله: «لقد كتبت أكثر من عشرة كتب على امتداد أربعين عاما من حياتي الأكاديميّة، ويبدو الآن أنني لا أفعل شيئا سوى الكتابة- بمعنى آخر، الكتابة هي «سبب وجودي»، ولا داعي لوجود أي حافز إضافي! وقد ركّزَت أعمالي السابقة على الاستعمار وما بعد الاستعمار، مبنيّة على فرضيّة أن القوميّة حلّت أولا ثم تبعها الاستعمار.
كانت القوميّة هي الجانب الجيّد، والاستعمار هو الجانب السيئ. تجلّى الجانب الجيّد في أوروبا، والجانب السيئ خارج أوروبا. هذا الكتاب يبدأ بمساءلة لهذه الفرضيّة، بعد إدراك أن الاستعمار والقوميّة ولدا بالفعل معا، ويمثلان وجهين لعملة واحدة».
يذكر أن محمود ممداني عالم اجتماع ومفكر سياسي أوغندي من أصول هندية وأمريكي الجنسية، يُعد من أبرز المنظرين في مجال دراسات ما بعد الاستعمار والسياسة الإفريقية. أستاذ في جامعة كولومبيا وحاصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد. محمود ممداني هو أيضا والد زهران ممداني الفائز أخيرا بمنصب عمدة مدينة نيويورك وزوج المخرجة الأمريكية من أصول هندية المعروفة (ميرا ناير).
في متاهات القول.. قراءات نقدية
تتطرق الكاتبة والناقدة المغربية العالية ماء العينين، في كتابها «في متاهات القول.. قراءات نقدية»، إلى مرحلة هامة في حياة محمد شكري مستنطقة رسائله المتبادلة بينه والكاتب محمد برادة التي تكشف أوجها أخرى للكاتب: «ما الذي يمكن أن يجعل محمد شكري، الغاضب، اليائس، الساخط، كما عمَّدته سيرة الخبز الحافي، راضيا عن نفسه»؟ «ورد ورماد» كتاب صدر سنة 2000 يحمل مجموعة من الرسائل المتبادلة بين محمد برادة ومحمد شكري.
يقول برادة في تقديمه لها: «قد تكون مضيئة لبعض التفاصيل التي التقطتها الرسائل وهي في حالة مخاض وقد ترسم ملامح أخرى لا يتسع لها النص الإبداعي». التقطتُ هذه الإشارة، ورحت أفتش عن وجه آخر لنصوص محمد شكري بين هذه الرسائل، خصوصا، تلك التي كتبها وهو في مستشفى الأمراض العقلية، والتي حمل بعضها توقيع «شكري… الراضي عن نفسه»، ويسمّيها بالرسائل «المستشفائية» كما ورد في إحداها. عددها ثمانية، كتبها في الفترة الممتدة بين 18/12/1977 27/12/1977 أي خلال عشرة أيام. وهذا يعني أنه كان يكتب يوميا تقريبا، إلا في رسالتيه الأخيرتين حيث يفصل بينها يوم عن سابقتها. وهذا يفسر عدم وجود أية رسالة من محمد برادة خلال هذه الفترة.
هل كان شكري راضيا عن نفسه خلال هذه الفترة؟ وما هي مظاهر هذا الرضى؟ وهل انعكس ذلك على تصرفاته وعلى علاقته بمحيطه؟ هل وجود شكري داخل جدران المستشفى يظهر وجها آخر غير معتاد؟
يقول الفيلسوف والمعلم الهندي، كريشنامورتي جيدو إن الخوف من الوحدة يدفعنا للهروب، إلى الكنائس والمساجد أو الاستماع إلى الراديو أو القراءة، الكأس، الجنس… فهل يهرب شكري من الوحدة إلى المستشفى؟
في آخر رسالة كتبها قبل دخوله المستشفى، يبدو في غيبوبة اختيارية عن العالم. يقول لبرادة: «عندما استلمت رسالتك كنت شبه فاقد وعيي، جد سكران… وضعتها في جيبي ولم أقرأها إلا بعد يومين». إضافة إلى ذلك تعبر الرسالة عن حالة خصام شديدة مع الناس ومع نفسه ورغبة في الابتعاد عن كل شيء: «كنت جد متخاصم مع نفسي وأيضا مع الناس»، ويصل غضبه إلى مداه فينفجر بأسلوبه المعروف: «عندما أمتلئُ غضبا أبول على الأشخاص ويبولون علي ثم أبول على نفسي فرحا أو حزنا لأحقق للكلبيين زمنهم المنسي».
هذه الصورة التي التصقت بشكري والواضحة من رسالته، ستتلاشى داخل المستشفى، وكأننا أمام مسرحية أو عمل درامي في ديكور جديد وفضاء مختلف تنقلب فيه الأجواء والصور والحكايات ويليق بتوقيع «الراضي عن نفسه». صور بعيدة عن الظلمة والخوف والروائح الثقيلة. في المستشفى يبدأ نهاره مبكرا محملا بانتعاش البرتقال. «أفقت هذا الصباح حوالي الخامسة، المرضى نائمون. بقيت في فراشي. أكلت برتقالة ثم دخنت سيجارة… وأخذت أقرأ».
وفي رسالة أخرى يقول: «الساعة الآن خمس دقائق نحو العاشرة. استيقظت في المستشفى في الخامسة صباحا. أكلت برتقالتين ودخنت أول سيجارة ثم رحت أقرأ». أوّل ما يثير الانتباه أن هذه الرسائل يومية. عكس ما كانت عليه قبل ذلك. فبينما يقول في آخر رسالة قبل المستشفى «منذ شهرين لم أكتب سوى خواطر»، يقول في أول رسالة من داخله، ضمّها الكتاب، «الإحساس بالكتابة بدأ يغزوني في هذا المستشفى» نفس الشيء بالنسبة للقراءة والتي تحضر في كل الرسائل تقريبا، رواية «زمن الصمت» و»لوف ستوري»، والشعر، بل إنه يتمتع بمناقشات فكرية، أدبية وفنية مع رفاق المقهى والدكتور الجعيدي، الذي يقول عنه «إنسان مثقف، يهتم بالأدب والفن، عموما، وبالمذاهب السياسية والفكرية».
رسائل شكري من المستشفى تحمل إحساسا بالحرية والانطلاق، وكأنه غادر سجن حياته اليومية إلى فضاء أرحب. يتجلى ذلك في كونه يكتب رسائله يوميا من المقهى، نيبون أو ما نيلا، ثم يتحدث عن ذهابه إلى طنجة لقضاء بعض حوائجه أو للعمل والعودة إلى المستشفى. يقول: «… في اليوم التالي سأعود من جديد إلى المستشفى لأقضي كل عطلتي». المستشفى فضاء للعطلة والانطلاق والتحليق حتى وإن يكن بأجنحة إيكاروس.
في هذه الرسائل نكتشف شكري المنفتح على محيطه، في حالة انسجام ورغبة في لقاء الناس والتفاعل معهم سواء من قاطني المستشفى أو أصدقائه الذين يلتقيهم في المقهى. وهذه بعض النماذج من رسائله:
«داخل المستشفى، أتمشى وحيدا أو أجالس أحد المرضى فيحكي لي عن مآسي حياته». وفي أخرى يقول: «أنت ترى أن علاقاتي محدودة ومع أناس لا يزعجونني ولا أزعجهم».
يمكن أن نصف حالة شكري في مستشفى الأمراض العقلية على لسانه، بأنها إحساس بصفاء ذهني غريب كما يقول مخاطبا برادة، بل ويؤكد أنه لا يشعر بأي ملل. هذه الحالة جعلته يفكر في تغيير حياته وهي رغبة كانت حاضرة في جل رسائله. «عندما سأخرج من هنا سأحاول أن أغيّر حياتي نحو الأجمل»، «سأبقى هنا حتى آخر هذا الشهر ثم أعود إلى طنجة لاستئناف عملي مغيرا نمط حياتي»، «كم أتمنى أن أكون بعيدا في بلد لا يعرفني فيه أحد ليكون لي من جديد أول صديق، أول خصم، أول عمل لم أمارسه من قبل إلى ما لا نهاية من الأوائل».
في المستشفى نكتشف محمد شكري المنضبط لقوانين صحته، حيث يتوقف عن شرب الكحول، وحتى الرغبة فيه لم تعد توتره كما يؤكد لبرادة. والمنضبط للمجاملات الاجتماعية، حين يطلب من برادة أن يشكر الطبيب الذي يعالجه: «صحتي تحسنت كثيرا بفضل عناية الدكتور الجعيدي. أرجو أن تكتب له رسالة شكر نيابة عني». وحتى عندما يشير إلى بعض مشاكله أو صراعاته مع أحد المرضى، فإن ذلك لا يخدش صفاء تلك الصورة التي نسجها شكري بين ثنايا كتابته اليومية لبرادة والتي تبدو على شاكلة مذكرات يومية يكتبها لنفسه.
رسائل شكري «المستشفائية» غنية جدا في إيحاءاتها ودلالاتها وتستحق قراءة متأنية متعمقة، لاستنطاق أوجه أخرى في كتاباته.
جائزة «سرد الذهب» 2025
أعلن مركز أبو ظبى للغة العربية عن القوائم القصيرة للدورة الثالثة من جائزة «سرد الذهب» 2025. وتضمنت القائمة القصيرة لفرع «القصة القصيرة- الأعمال السردية المنشورة»، أربع قصص، هي: «الرحلة إلى جبل قاف»، للكاتب المغربي محمد سعيد احجيوج، والصادرة عن «دار مرفأ» في العام 2024، و«كل ما يجب أن تعرفه عن ش» للكاتب أحمد الفخراني من مصر، والصادرة عن «دار الشروق» في العام 2024، و«زمن سيد اللؤلؤ» للكاتب يوسف ذياب خليفة من الكويت، والصادرة عن «دار منشورات ذات السلاسل» في العام 2024 و«استعادة فراشة الصدر»، للكاتبة العراقية الدنماركية دنى غالي، والصادرة عن «دار صفصافة للنشر» في العام الجاري 2025.
وفي قائمة «القصة القصيرة للأعمال السردية غير المنشورة» أعلن المركز عن ستة أعمال، هي: «أصوات البرية» للكاتب مصطفى ملح من المغرب، و«نزيف الأطياف» للكاتب عبد البر الصولدي من المغرب، و«أكثر من أربعين شبيهاً» للكاتب محمد منصور محمد من مصر، و«حكايات مزدوجة» للكاتب شريف صالح من مصر، و«بئر الغياب -من حكايات الماء في الأساطير العمانية»، للكاتبة غالية علي من سلطنة عمان و«شجرة الفساتين» للكاتبة نور الموصلي من سوريا.