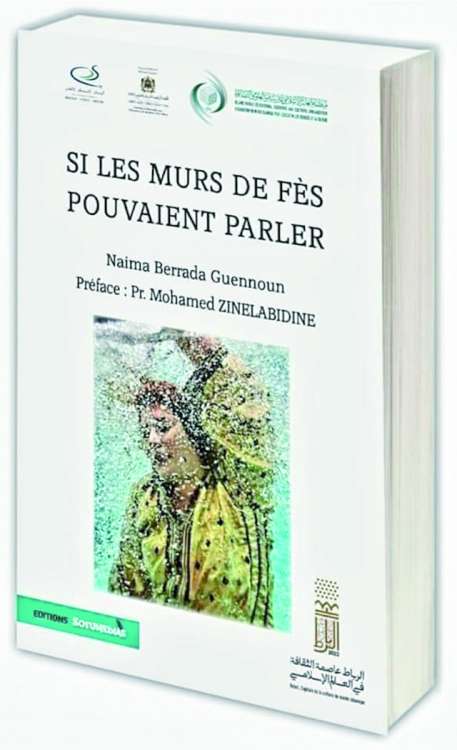لأنها تتقاسم نفس القيم والمثل، كانت العائلات الفاسية حريصة على أن تقيم في ما بينها علاقات اجتماعية متينة وودية. كان المتسولون، سواء من يطرق منهم الأبواب أو من ينزوي منهم في ركن من أركان الدرب، يحصلون على ما يكفيهم من إعانات غذائية، وألبسة ونقود. لم يكونوا يوما ما ملحاحين، فبالأحرى أن يتحولوا إلى شرسين أو عدوانيين. كانوا يميلون إلى التكتم، ويتحلون بالبشاشة، لدرجة أننا كنا نبادر من تلقاء أنفسنا لتقديم المساعدة إليهم، حتى المرضى العقليون الذين لم يكن لهم سكن قار، والمنتشرون في الأزقة، كانوا يحظون بنفس الاهتمام والعطف والتقدير من طرف الجميع. كنت أحب أن أنجز مهام السخرة لأمي، كلما تعلق الأمر بمساعدة الجيران الذين كانوا يعانون من الفقر أو العوز. هكذا اكتشفت منازل صغيرة ومتواضعة يقطنها أشخاص أباة، وأغنياء بأخلاقهم العالية وعفة نفسهم. كان هؤلاء الناس الطيبون الكرماء على ضعفهم يهدونني في كثير من الأحيان قطعة من الحلوى، كانوا يدخرونها خصيصا لي! بصفة عامة، كانت الأسر التي تكابد شظف العيش وأطفالها محط عناية خاصة من طرف جيرانهم الأغنياء، كنا باختصار شديد نتراحم في ما بيننا.
 ترجمة: أ.د. خالد فتحي
ترجمة: أ.د. خالد فتحي
كان منزل جداي من جهة أمي يعج بالزيارات على طول اليوم، فبابهما كان مفتوحا بشكل دائم. في المرات النادرة التي صادفته مغلقا، كاد قلبي ينخلع من مكانه جزعا عليهما. فأنا كنت دائما أجد الأقارب يحطون الرحال عندهما، أو أصادف أحدهم وهو ينزل حمولة البغال، المثقلة بمختلف الخيرات والثمار المجلوبة من البادية المحيطة بفاس، والتي كانت تختلف طبعا في محتوياتها باختلاف فصول السنة.
كان جدي لأمي فلاحا، ولذلك كان مفروضا أن يخصص جزءا من محاصيله الزراعية لتأدية الزكاة. أما عائلتي من جهة الأب، فقد كانت تمتهن التجارة، ولذلك كانت تؤدي نسبة من رقم المعاملات للمحتاجين، لأجل الامتثال لتلك الشعيرة الواجبة. كان ذلك بالنسبة إلينا سلوكا تضامنيا ودينيا واجبا، بل وركنا أساسيا من أركان شريعتنا السمحاء.
كانت المناطق المجاورة لفاس تصدر إليها الحبوب، والخضر، والفواكه، والدواجن، والماشية. إذ كثيرة هي العائلات التي كانت تتقاسم بستانا يدعونه «جنانا» بضواحي المدينة، أو مزرعة صغيرة عند سفح جبل زلاغ، يتم تخصيصهما لأجل ضمان حاجياتها السنوية.
كانت البغال وهي تحمل على ظهورها إلى المنازل المواد الغذائية والمواشي المنذورة للذبح لأجل إعداد اللحم المجفف المسمى «الخليع»، الأكلة التي تشتهر بها مدينة فاس، مشهدا يجري على مرأى ومسمع من الجيران. كان ذلك يعد حدثا استثنائيا يفرض علينا أن نبعث إليهم بما يسمى «الذواقة»، أي عينة يتذوقونها من هذه الأكلة الخاصة، حتى لا نتهم بغياب الحس الاجتماعي وانعدام فضيلة التراحم.
كانت العائلات التي تمتلك إقامات فخمة تمنحها مجانا للآخرين، من أجل تنظيم الحفلات والمناسبات، بل وقد تتطوع لإسداء خدمات إضافية أخرى يحتاج إليها الحفل. كان للتعاون بين الأسر مظاهر مختلفة: هبات مالية، تهييء الكعك والحلويات، إقراض الأواني أو الجواهر أو الحلي، بل لم يكن هناك حرج أيضا من إقراض الأزياء المخصصة لحضور السهرات. فمن غير المقبول، أن شبابا نما وترعرع داخل الحي، لا يستفيد من المنازل الفسيحة للجيران، إضافة إلى ذلك كان دائما ما يوجد بيت ملحق بذاك المنزل الذي يحتضن الحفل يكون مخصصا لراحة الضيوف، يطلق عليه اسم دار «يسلان»، وهو اسم مشتق من المصطلح الأمازيغي «إيسلان» الذي يعني «عروسين». كنت دائما أعتقد أنه لا يوجد معنى أو مرادف لهذه التسمية في لغتنا العامية. وعندما نشرت مقالات على «فيسبوك» تطرقت فيها إلى تلك العادة، شرح لي بعض رواد الإنترنت بأن أصل هذا التقليد أمازيغي، وأنها عادة منتشرة حتى في جنوب المغرب. أحدهم حاول جاهدا أن يوضح لي ما يلي: «دار يسلان تعني باللغة الأمازيغية بيت العرسان الجدد. ففي هذا البيت يمضي العروسان عموما ليلة الدخلة أو لياليهما الأولى، حسب تقاليد كل جهة». أتذكر الآن أنه في ذاك العهد كانت الحدائق أو العرصات هي من تتحول إلى دور «يسلان» كلما حل القيظ أو الحر.
كم أنا معتزة، بالمناسبة، بالطابع الوطني لعاداتنا وتقاليدنا وبقاموس اللغة الأصيلة لمدينة فاس. دار «يسلان» كانت مرصودة للقاءات العريس الشاب بأقرانه وأصدقائه طيلة أيام الاحتفال الخاصة بزواجه، لكي يقطع بشكل سلس وتدريجي مع أيام العزوبية.
كان تقديم المساعدة، والتقاسم، من صميم ثقافة العائلات، كل منها حسب مستواها المادي. هذا التضامن كان قيمة تطفو على السطح، عند الأتراح والأفراح على السواء، وفي أوقات الشدة والرخاء، وعند اليسر والعسر، وفي الحفلات والجنازات، مما كان يصهر الجميع في بوتقة واحدة، ويلحم الفئات في ما بينها في بناء متراص ومتماسك.
أتذكر أنه كان هناك إجماع بين كل المتفاعلين بخصوص تدوينتي بـ«فيسبوك»، على ضرورة ترسيخ مثل ذلك التضامن والتآزر بين الناس في كل المناسبات. فمثلا كان أمرا مألوفا لنا في ذاك الوقت أن تتكفل عائلة غنية بعائلة من الشرفاء أو بعائلة فقيرة، بل إن جدي من جهة الأم كان قد زوج اثنتين من بناته لشابين من الشرفاء مع إهدائهما ملابس ومحلا للتجارة، ومنزلا. وتعبيرا عن عرفانها، أرسلت أسرة أحد الأزواج، في طلب خالتي الكبرى، طوطما «كوبة»، وهي عبارة عن دمية كبيرة ترتدي ملابس زاهية ومزركشة كالعروسة.
كان الدور الأساسي للجد أن يجلب جزءا من محاصيله الزراعية إلى المنزل، وبمساعدة جدتي لَلاَّمليكة، كانا يسعدان معا بتوزيعه على المحتاجين من الأقرباء أو الجيران أو غيرهم من الناس، حسب درجة عوز كل واحد منهم. كان ذلك مثالا على التقاسم الذي ينبغي أن يؤطر العلاقات داخل الحومة (الحي). كانت تلك الإمدادات الموضوعة داخل ركن من فناء المنزل لا تتأخر لكي تصل إلى مستحقيها، أو كانت تخزن في القاعة الكبرى المخصصة لذلك، والتي كنا نطلق عليها اسم «سكلابية»، أو لخزين. كان هناك أيضا «الخَبْيَاتْ»، وهي عبارة عن جرار من الصلصال ذات شكل بيضاوي يوضبها الفخارون، تستعمل لحفظ البقوليات، والزيت، والزبدة المملحة أو السمن، والعسل، واللحم المجفف، والفواكه الجافة.. جزء مهم من هذا المخزون كان يتم توزيعه أيضا في بحر السنة.
كانت للامليكة غالبا ما تكلفني بإعطاء بعض الصدقات إلى الفقراء، الذين كانوا بدورهم يقابلون ذلك الصنيع بعرفان جميل، فلا يتورعون عن الدعاء لي والثناء علي، كنت أجيبهم: «لا داعي لكل هذا الدعاء، فلست إلا مجرد وسيطة»، لكنهم كانوا يعقبون قائلين: «عندما تكبرين، ستتبعين الطريق نفسه لعائلتك. بلغي سلامنا إلى جدتك الخيرة للامليكة». كم كنت عظيمة يا جدتي، وكم من الفضائل تشربتها منك، وكم قد تعلمت منك الكثير.
صراع مع الجدة
في إحدى المرات، كانت جدتي قد اقترحت علي أن تمنحني سطلين من الحمص لأجل الوفاء بصفقة عقدتها مع بائع الحمص المقلي، الذي وافق على أن أقايضه بهما مقابل سطل من حمصه الجاهز للأكل. كنت تسلمت بضاعتي منه التي حملتها معي رفيقات من قسمي يسكن بجانب منزل جدتي. ذرعنا معا الطريق الطويل الذي يمر من أحياء، الطالعة، سويقة بنصافي، زقاق الرواح، والطرافين، إلى أن وصلنا إلى زقاق الرمان، ونحن نلقم الحمص إلى أفواهنا كل حسب انفتاح شهيتها. كنا سعيدات جدا لعدم إحساسنا ببعد المسافة.
وعند وصولنا إلى منزل للامليكة (الجدة)، كان السطل فارغا. ولكم شعرت آنذاك بالخجل حين بادرتني قائلة: «كنت أظن أنك ستحتفظين لي على الأقل بحفنة من الحمص»، لكنها عادت لما لاحظت علامات التأسف على وجهي، لتطلب مني أن أعاود الصفقة مرة أخرى، وأن لا أنسى نصيبها في المرة القادمة. هكذا تمثلت حقيقة أن الكبار بدورهم يحتاجون منا أن نبادلهم العطف نفسه الذي نكنه لمن هم في سننا. وحين أصبحت شابة، كان من ضمن ما أحرص عليه بانتظام، أن أقدم إلى جدتي هدايا جميلة كلما سنحت لي الفرصة. كانت تتقبل تلك الهدايا بفرحة بادية، وتقول لي: «صاحب التاج محتاج». كانت تقصد بصاحب التاج الملك طبعا.
كانت الحفلات المتنوعة تجري دائما في الدروب والمنازل التي نتردد عليها. وكان مشاهدة الآباء، وهم يجلبون الجمال والأبقار المخصصة لتخزين اللحوم، مشهدا يخلب الألباب.
أتذكر مثلا، أن الجمل كان يمانع في الدخول إلى الدار دون أن يكون مرفوقا بأنثاه الناقة. كان ذلك بالنسبة إلينا نحن الأطفال أمرا لا ينبغي أن يفوتنا.
أطفال محترمون
كنا نتجول بحرية في مدينتنا العتيقة، إذ إن كل السكان بكل الأحياء كانوا يسهرون على ضمان سلامتنا. لم يسبق لي أن بلغ إلى مسامعي حادث اختطاف لأي طفل. كل الإحصائيات المتعلقة بتلك المرحلة تدل على أن حالات السرقة والجريمة كانت نادرة جدا، فبالإضافة إلى الحماية التي كان يضطلع بها الآباء، كانت هناك رقابة محكمة تتم تحت عيون السكان وعيون التجار وكذا المارة أيضا. كانت هندسة المدينة العتيقة ذات الأزقة الضيقة توفر تلك القدرة على ضبط أية حركة مريبة، وأي تصرف خادش يمكن أن يخل بالسكينة والطمأنينة. ومما كان يدعم أيضا كل هذا، تلك الروح الجماعية التي كانت تسود لدى الساكنة. فالكل كان متشبثا في أعماقه بثقافة الاحترام والتضامن البيني. كان لهذه القيم حمولة كبيرة في نفوس الناس: الحشومة، كانت تعني «أنه يجب أن تشعر بالخجل. أو أنه لا يجب فعل ذلك»؛
– حشومة أن تؤذي جارك أو أطفاله؛
– حشومة أن لا تتشاطر الماء مع من بجانبك؛
– حشومة أن ترمي القاذورات بجانب باب جارك؛
– حشومة أن لا تدعو الجيران في المناسبات والحفلات؛
– حشومة أن لا تجعل جارك يتذوق معك أكلة خاصة قمت بإعدادها إلخ.
كان للعلاقة بين بنت وولد الحومة – بنت وابن الحي- سمات اعتبارية مميزة. كانا يشبان معا في جو من الثقة الكبيرة، ويترعرعان جنبا إلى جنب في وسط يقوم سكانه بتأمينه باستمرار.
ورغم أن السلطة الإدارية كانت حاضرة من خلال ممثليها، فإننا لم نكن نشعر بوجودها لحرصها على التحرك في الظل. كان المقدم (ممثل الدولة المسؤول عن الحي) يتم اختياره من طرف القاطنين بالحي. كان غالبا ما يجري انتقاؤه من العائلات المعروفة، مما كان يشكل عامل ضغط معنوي عليه يجبره على ربط علاقات احترام مع كل العائلات التي درج أيام طفولته الأولى أمام ناظريها. بمقابل ذلك، كان للمقدم وقار وهيبة وتقدير ينالهم من كل الناس، الذين كانوا يحرصون بشكل تلقائي على مساعدته وتسهيل مهمته.
أتذكر جيدا المقدم «سي بناني» الذي جلبت إليه في العديد من المرات علبا مليئة بالهدايا، كتعبير عن عرفان العائلة ببعض خدماته التي أسداها لها. ستون سنة بعد ذلك، سيقوم حفيده المرحوم سي بنجلون، المهندس والكاتب، بإحياء ذكريات التضامن تلك التي كانت تميز حي زقاق الرمان التي كان شاهدا عليها. كان كل غريب يدلف إلى الحي يرصد بسرعة فائقة، وتجري مراقبته وتعقبه. فهذه الحرية التي لم تكن تقدر بثمن، والتي منحت للأطفال والشباب، ما كانت لتتاح لهم إلا بفضل بيئة حاضنة آمنة في متناول الجميع منذ الطفولة. لم أكن أخاف أبدا أن يتم اختطافي، أو أن تسرق مني أدواتي المدرسية. كان الطفل في الدرب عبارة عن سيد، عن ملك صغير حقيقي، كنا نتجول بملء إرادتنا، ونقف عند واجهات المحلات دون أن يتحرش بنا أحد. كانت تلك المحلات تعكس مختلف المهن التي يحتاج إليها الناس: الحدادون، النجارون، الخراطون، النساجون، الذهايبية (صانعو الذهب) إلخ. كان هؤلاء الأخيرون يمنحونني، كلما طلبت منهم ذلك، مذكرات صغيرة كانت تحتوي على وريقات ذهبية، وكنت أستعمل هذه الورقات لأجل نسخ بعض الرسوم. أحد هؤلاء الذهايبية، وكان يدعى «سي التازي»، كان ينادي علي كلما مررت بمحاذاته ليمنحها لي، وكنت كلما فتح خزانته لأجل إخراج تلك المذكرات، أشعر كما لو أن مغارة علي بابا تفتح لي، وأني سأرفرف قريبا بجناحين عاليا في السماء فوق بساط علاء الدين. كانت أياما جميلة لا تنسى. حتى الباعة المتجولون كانوا يكنون احتراما كبيرا للأطفال، كانوا يعرفون كيف ينسجون علاقات ودية معهم. من جهتنا نحن، كنا نحب منهم بشكل أكبر أولئك الذين كانوا يتبرعون علينا بكؤوس الليمون المبرد والمثلجات، خصوصا خلال فصل الصيف. لذلك كنا بمجرد ما نسمع أصواتهم التي تدعو المارة إلى شراء بضاعتهم، إلا ونتحسس جيوبنا لنتفقد قطع النقود التي بحوزتنا.
لم تكن أمي تقلق من تأخري في الخارج، ولا من توقفاتي لأجل تأمل إبداعات الصناع والحرفيين المهرة، الذين كانت تغص بهم فاس، لكنها كانت صارمة بشأن احترام موعد وجبة الغداء بالمنزل، وتصر على أن أعود إلى البيت قبل حلول الليل.
كيف تغير نمط العيش بالمدينة خلال سنوات؟
بمرور السنوات، بدأت فاس تفقد ملامحها، وتتحول عن سماتها الأصيلة. صارت تخسر رويدا رويدا من رونقها القديم وبهائها الجميل، فدون أن نحس بذلك، شرعت عقلية جديدة في الظهور والتجذر داخل المدينة…، عقلية لا تعكس بتاتا ثقافتنا، ولا يمكن من جهة أخرى أن نحسبها على الانفتاح المرغوب فيه على الحداثة. فجأة، ارتفع عدد سكان فاس، أشخاص كثر قدموا من البادية، وغير مطلعين على نمط عيشها، صاروا يبحثون عن الرزق فيها، وينشدون تمدرس أبنائهم، وهو ما دفع بالساكنة القديمة إلى الانطواء على نفسها خوفا من «الغريب»، هكذا بدأ الشرخ الأول في اللحمة والبناء الذي كان يوحد الجميع. بالإضافة إلى ذلك، حدث أمر آخر غير متوقع، إذ بمجرد ما كبر الأطفال الصغار وشبوا عن الطوق، وشرعوا في الاعتماد على أنفسهم من خلال تحقيق بعض الدخل، حتى نأوا بأنفسهم عن المنازل العائلية التقليدية، فالأزواج الجدد، وعلى غير طباع آبائهم، صار يغويهم النموذج الغربي العصري في الحياة، فبدؤوا تباعا في الانتقال للعيش في الشقق، التي اعتبروها أكثر ملاءمة لحياتهم الجديدة. هكذا بدأ الانهيار التدريجي للسلطة الأبوية.
لم تقف النساء بدورهن لا مباليات إزاء هذه التحولات الجارية على قدم وساق، فقد خرجن بدورهن إلى عالم الشغل، بعد أن اكتشفن أنه يدر مدخولا أعلى من العمل المنزلي. بدأن يطالبن لأول مرة بعلاقة تقوم على المساواة مع الأزواج، وشرعن يتمردن على ما لا يروق لهن من قواعد، كانت في ما مضى غير قابلة للنقاش مع عائلة الزوج. إضافة إلى ذلك، سيقع النزوح الكبير للعائلات الأصيلة لفاس، من منازلهم الفخمة الفسيحة بالمدينة العتيقة، إلى المدينة الجديدة والأحياء الهامشية، التي سوف ترى النور على حواف المدينة. هكذا سيتم إقفال البيوت القديمة، أو تقاسمها من طرف عدة عائلات.
ولسوف تؤثر هذه المستجدات الاجتماعية في النشاط الاقتصادي والاجتماعي لفاس العتيقة، فيتراجعان بشكل مثير. فبعد أن كانت فاس تعد أكبر قطب صناعي بالمغرب، ستصبح مدينة متعبة منهكة بمجرد ما انتقلت منها أغلب الصناعات، والمشاريع الاقتصادية إلى مدن ساحلية كالرباط، الدار البيضاء، والقنيطرة، طنجة إلخ.
لكم أشعر بالامتنان لكل عشاق المدن التقليدية المتيمين بتاريخها التليد، مغاربة وأجانب، وأنا أراهم يرفضون رفع الراية البيضاء، ويحاولون بأقصى جهدهم إحياءها من جديد، وتأهيلها جنبا إلى جنب مع المساعي التي تبذلها الدولة.
كانت فاس المدينة الميتروبولية، وملتقى الثقافات والحضارات، قد آلت على نفسها قبل العصر الحديث أن تحسس السكان بحسنات التنوع والاختلاف. فالمدينة التي كانت عاصمة لأربع إمبراطوريات عظيمة، لا يمكنها إلا أن تستوعب وتنتمي إلى الجميع. كل العلماء والمؤرخين المغاربة والأجانب أقروا لها بهذه الفضيلة الحضارية التي تتجلى في انفتاحها على الكل ودمجها لهذا الكل في بوتقة واحدة. هكذا كانت فاس إذن في سالف الأزمان، وهكذا ستبقى للأبد.