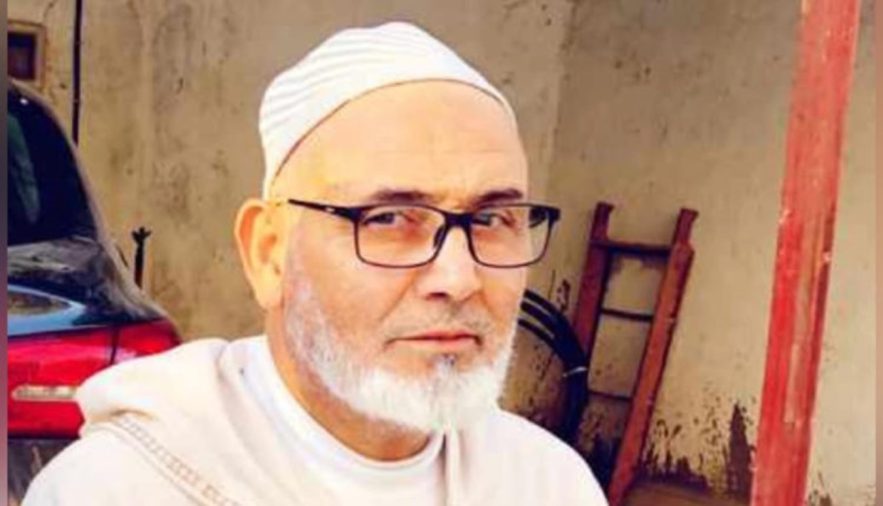عن معضلة فرض معايير عالمية للعدالة على كل الشعوب
كتاب "اللامساواة بين العولمة والخصوصية" لألان رونو

يتوافق كتاب “اللامساواة بين العولمة والخصوصية” مع برنامج بحثي أساسي يتناول التحولات في فهم التفاوت في نظريات العدالة المعاصرة وما بعدها. ويتكون الكتاب من جزأين. يُجري الجزء الأول بحثًا أساسيًا يهدف إلى رسم خريطة فكرية لنظريات العدالة ومستقبلها. ويستكشف الفرضية الجديدة القائلة بأن مرحلة بناء نظريات العدالة (1970-1980) قد اكتملت. وقد أُثريت هذه المرحلة من التنظير بالنماذج (النفعية، والليبرالية، والليبرالية، والجماعية، والجمهورية) منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا بمنهج جديد لفهم التفاوت. ويؤكد البرنامج على كيفية تكامل أو تأثير المناهج المختلفة لتفسير التفاوت (من خلال الموارد، والرفاهية، والقدرات) على التمثيلات المستمدة من النماذج النظرية، وتأثيرها على تحديد الأجندات المتعلقة بمعالجة ظاهرة التفاوت الاجتماعية أو العالمية.
اللامساواة بين الثقافات
يعتمد الجزء الثاني على البحث التطبيقي. ينتقل التفكير في اللامساواة في المجالين المجتمعي والبين مجتمعي إلى مجالات تُبرز فيها اللامساواة اختلافات في محتواها وشدتها ومرونتها وتطورها. سيؤدي هذا التحول في التركيز نحو قطاعات اللامساواة إلى استكشاف أعمق للفرضية المحورية المتمثلة في إحداث تحول في فهم اللامساواة، يتجاوز النظريات العامة للعدالة، من خلال دمج مناهج متعددة تحافظ على صلة وثيقة بمجالات التطبيق التي تتقاطع فيها في توليفات محددة.
ولاختبار هذه الفرضية، سيركز هذا الجانب من الكتاب على ثلاثة مجالات بحثية رئيسية تُركز على ظهور اللامساواة: اللامساواة في التنمية ومسألة العدالة الانتقالية والفجوة الرقمية؛ اللامساواة بين الثقافات ومسألة اللامساواة أمام القانون وتطبيقه؛ اللامساواة بين الجنسين ومسألة العدالة بين الأجيال. عبر هذين الجزأين من المشروع المقترح، سترافق الأسئلة المهمة والجوهرية المتعلقة بنظرية المعرفة ومنهجية البحث، الموضحة في الاقتراح، كل من البحث الأساسي والتطبيقي، إلى الحد الذي تم تحديده هنا كواحدة من المهام الثلاث المكونة للبرنامج.
إن تحديد نقطة الذروة في هذا التسلسل، الذي حاولت الفلسفة السياسية منذ ذلك الحين إعادة تحديد موقعها بالنسبة له، يعود لبداية ومنتصف تسعينيات القرن العشرين، عندما تم نشر مؤشر التنمية البشرية من جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتحديدا سنة 1990، ثم إنشاء منظمة التجارة العالمية سنة 1995، وهي منظمة، أو فوضى، للتجارة العالمية لم يتوقف جوزيف ستيجليتز، في كتبه كما في تقاريره، عن الدعوة إلى التأمل النقدي بشأنها.
أثناء تنفيذ راولز أول مشروع لهذه النظرية التي تهدف إلى بيان وتبرير مبادئ العدالة في مجتمع منظم، أدان صراحةً أي محاولة لتحويل التساؤل حول مبادئ العدالة الاجتماعية هذه نحو معايير مماثلة للعدالة العالمية، والتي كانت ستعالج مسألة التفاوتات الجائرة وغير المبررة في العلاقات بين الدول الغنية والفقيرة، في الواقع، في تسعينيات القرن الماضي، وجد سين وستيجليتز في أسلوبهما في التساؤل “العالمي” أو “العالمي” عن العدالة أرضًا خصبة فجأةً لأسلوب تساؤل يرث إمكانية إعادة التوحيد السياسي للعالم، والذي ربما بدا لفترة وجيزة نتيجة سقوط الكتلة السوفيتية، وتحوله إلى سوق عالمية قابلة للإدارة الفورية من أي مكان، منذ عام 1995 فصاعدًا، بفضل تحول الإنترنت إلى أداة تقنية فعالة. وقد ظلت الفلسفة، وحتى الفلسفة السياسية، وفية لدورها كبومة “مينيرفا”. في معظم الحالات، انتظرت حتى أواخر التسعينيات للاعتراف بالتحول الناتج في التركيز، ولتحويل تركيزها من مسائل العدالة الاجتماعية إلى استفسارات جديدة تناولتها ما أصبح يُشار إليه عادةً، مع مطلع القرن، بنظريات العدالة العالمية.
هل هناك معيار واحد للعدالة عبر العالم؟
من ناحية، هل تُشكل المفاهيم التي تُقدم نفسها كنظريات للعدالة العالمية، والتي تنقل، في عنوانها، كما هو الحال في أغلب الأحيان، في نوع استجوابها، إلى المبادئ المعيارية أو استنادًا إليها، منهج نظريات العدالة الاجتماعية، الشكل الوحيد الممكن لمعالجة مسائل العدالة العالمية بتنوعها وأفضلها أو أكثرها استحسانًا؟ من ناحية أخرى، هل تحل هذه التصورات لـ”فكرة العدالة”، على حد تعبير سين (2010)، والتي تجددت على أي حال من خلال دراسة مسائل العدالة العالمية، محل التصورات التي اتخذت شكل نظريات العدالة الاجتماعية التي وضعت مبادئ معيارية للإنصاف على مدى أربعين عامًا، والتي امتدت لتشمل – وهو المصطلح المناسب إذًا -؟ هل يُحافظ الانتقال من المستوى الاجتماعي إلى المستوى العالمي على النظريات السابقة المتعلقة بالعدالة الاجتماعية دون تغيير، إلى جانب التساؤلات العالمية حول عدم المساواة؟ إذا كان الأمر كذلك، فوفقًا لأي إدارة، أو لأي تقسيم للعمل أو لأي توزيع للأدوار، ووفقًا لأي تمفصل خارجي (بالتجاور، أو حتى الاستمرارية) بين التساؤل القديم والجديد؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فكيف تنسجم مسائل الظلم الاجتماعي، التي تبدو للوهلة الأولى أكثر “محلية” أو “سياقية”، مع مسائل العدالة العالمية؟ نود هنا أن نحدد بعض عناصر الإجابة على هذين السؤالين من خلال تناولهما، ليس على التوالي، بل كما ينبثقان من المحور الرئيسي للبحث الذي استهل هذه الدراسة.
في الواقع، تتطلب منا متابعته مراجعة سريعة للأسئلة التي طُرحت للتو: كيف تُدير الفلسفة السياسية لعدم المساواة، اليوم، وعلى نطاق أوسع، منذ تغيير تركيزها في أواخر التسعينيات، الكنز الفكري الذي تراكم خلال إنتاج نظريات العدالة الاجتماعية (وهي مسألة واقعية)؟ وكيف يُمكنها، أو ينبغي لها، أن تُدير، ما تراكم على مدى ثلاثة عقود، وفقًا لزمنية تُعرف غالبًا بزمنية جيل، والتي يُضاف إليها الآن زمنية الجيل الذي أطلق وأدار التحول من الاجتماعي إلى العالمي. يمكن تصور إدارة هذا الكنز من الابتكارات المعيارية والجدلية وممارستها بطريقتين مختلفتين تمامًا: الأولى هي الأكثر شيوعًا في الفلسفة السياسية: فهي تتكون أساسًا من الحفاظ على الكنز من خلال توسيع نطاق الديمقراطية.
إن الفلسفة السياسية الشاملة والتطبيقية القائمة على البيانات لا تستبعد بأي حال من الأحوال إمكانية أن تجد المبادئ الكبرى والواسعة النطاق، التي تسردها نظريات العدالة، والتي بُنيت وتنافست فيما بينها خلال الفترة من 1970 إلى 1995، في ظل ظروف معينة، ليس فائدة جديدة، بل وظيفة ومعنى جديدين.
في نهج لم يعد ينطلق من المبادئ لادعاء بناء المجتمعات، أو حتى من العوالم البشرية الليبرالية أو الجماعية أو النفعية أو غيرها من العوالم المتنافرة تقريبًا، فإن هذه المبادئ ليست في بداية النشاط الفلسفي ولا في نهايته. كما أنها ليست مسألة انطلاق من البيانات لإعادة اكتشاف مبادئ العدالة، بعد تنقيتها من سياقها. فبعد أن تحررت من البناء النظري الذي، بعد أن حررها من بعض جوانبها، استحوذ عليها بطريقة ما لمصلحته الخاصة من خلال تحصينها ضد أي شكل من أشكال المنافسة، ستغذي مبادئ العدالة من الآن فصاعدًا، وبشكل أكثر وظيفية، أساس المعايير التي يحتاجها الفيلسوف. أي أساسٌ لمعايير تُستنَد إليها لتحديد قائمة الأجندات، في سياقٍ مُحدد، سواءً أكانت تتعلق بفهم الواقع أم بتحويله. وهو تحديدٌ بالغ التعقيد في السياقات المتطرفة التي يغلب فيها اعتبار الإلحاح، وكذلك تحديد الأولويات التي يجب تحديدها بين كل ما يُشار إليه بأنه أمرٌ ضروري وممكن.
وفي هذا التأسيس لعلاقات تحديد الأولويات أو تسلسل الأجندات، قد يُدرك السياسيون الحكماء أن وصفة الفلسفية-السياسية، إن لم تكن تهدف إلى تزويدهم بوسائل توجيه أفعالهم، فإنها مع ذلك أقرب إلى مجال تدخلهم، أكثر مما كانت عليه الحال في نظريات العدالة المثالية في العقود الأخيرة.
ما هي المكانة التي يتمتع بها هذا الأساس من المعايير التي تجعل الفيلسوف بحاجة إلى التفلسف من واقع التاريخ حول التفاوتات؟ بما أن هدف الفلسفة السياسية لم يعد إنتاج مبادئ معيارية، بل استخدامها لإلقاء الضوء على خصوصية حالات التفاوت العالمي الجائر، وخاصةً الأكثر تطرفًا، فإن هذا أيضًا، ليس بيانات تجريبية بل هو موضوع فلسفي.
هذه المبادئ المعيارية، التي تُفهم كمعايير لتقييم أو تعزيز أجندات لتحديد أولويات معيارية بحد ذاتها، تتوافق مع قبول مصطلح المعيارية الأكثر شيوعًا بين الفلاسفة منه في العلوم الاجتماعية وبين علماء الاجتماع الذين لا يغفلون ما هو معياري. فيميل كثير منهم، في الواقع، ولأسباب وجيهة بلا شك، إلى حصر مصطلح “المعايير” في وصف “عنصر استوعبه الفاعلون خلال تنشئتهم الاجتماعية”، وبالتالي يجدون “المعايير” في الوقائع الاجتماعية نفسها، كما تكشفها المسوحات مثلا.
وبالنظر إلى مجال القيم، الذي لا يعبر عنه إلا بصيغة محددة من خلال الأسئلة الناشئة عن المواقف، فإن معيارية الفلاسفة، على أي حال، ما نعتزم جمعه في قاعدة أو أكثر من قواعد المعايير، تتميز عن السياقات والبيانات التجريبية بكونها لا تنبع منها. ولا شك أننا نستطيع أن نجد شيئًا منها في وعي الفاعلين الموجودين هنا والآن، ولكن دون اختزاله فيها. لماذا يبدو هذا المفهوم للمعايير ضروريًا لنا، على الأقل لتحديد عمليات الفلسفة السياسية مقارنةً بعمليات العلوم الاجتماعية، دون تحسينها، أو، كما نأمل، جعلها أسوأ منها.
فالاختيار السياسي دائمًا ما يكون خاصا، بمعنى أنه يُتخذ في سياق، حتى وإن كان عالمي النطاق أو تُنفذه منظمات دولية، وينبع من أوضاع خاصة أو جهات فاعلة محددة. علاوة على ذلك، ندرك هذا اليوم من خلال تساؤلات العدالة العالمية التي يطرحها تغير المناخ بحكم تعريفه، سواء من حيث تقييم البيانات التي تُجمع الآن بتوافق الآراء أو من حيث الأجندات العالمية: فكما أن المعرفة الكافية ببيانات التغير، وهي بيانات ذات نطاق عالمي بالطبع (لأن الغلاف الجوي لا حدود له)، تؤدي إلى الرغبة في اتخاذ قرارات على مستوى عالمي، فإن مراعاة ضمير الجهات الفاعلة الوطنية (الحكومات والرأي العام) وغير الوطنية (الشركات والمناطق) لا يمكن أن تؤدي إلا إلى يأس عملي، من خلال إثارة وجهات نظر محلية، والتي تقبل بصعوبة بالغة اللامركزية لمراعاة المصالح العليا.
باختصار، في هذا القطاع من العدالة العالمية، نرى كل يوم أن الترجمة السياسية لتغير التركيز لا تزال مهمة شاقة. سبب إضافي لعدم الاستنتاج، بتبسيط مفرط لبيانات التأمل، أن التحول من الاجتماعي أو المجتمعي إلى العالمي أمرٌ محسوم. بل إن النهج العالمي لظواهر التفاوت الجائر، على سبيل المثال عند تركيزه على مسألة الفقر العالمي، يجب أن يركز في المقام الأول على الحالات الأكثر تحديدًا، وهي حالات البلدان والمناطق التي تعاني من الفقر المدقع. قد يكون هذا في الواقع هو المحور الحقيقي لمسائل العدالة أو الإنصاف، لا الاجتماعية ولا العالمية. في شكلها المتطرف، تُضفي هذه الأسئلة تطرفًا على رهاناتها في مواقف مختلفة تمامًا عن بعضها البعض، وبعيدة كل البعد عن بيانات المجتمعات شبه المثالية، وهي تلك التي يبني فيها الفلاسفة نظريات عامة للعدالة العالمية.