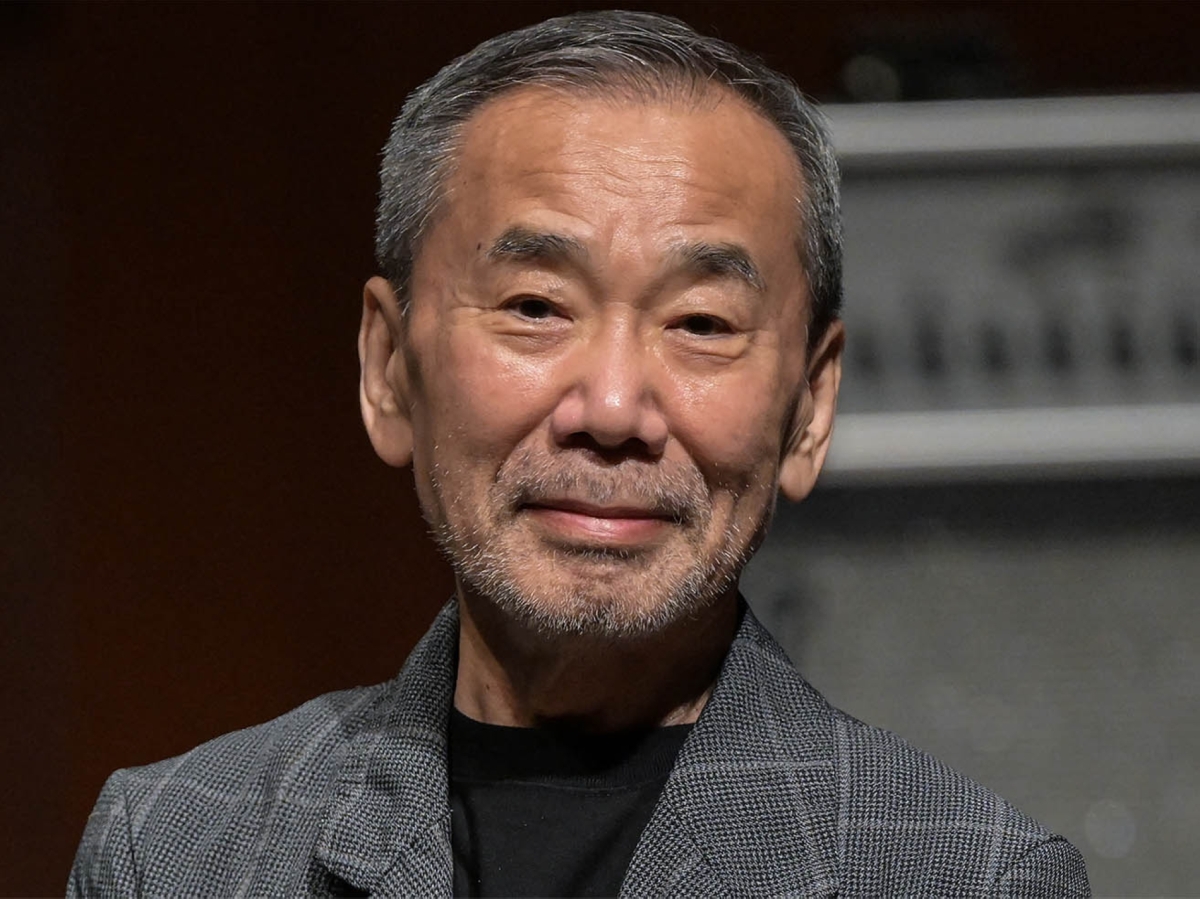محمد منضوري
طوال الأسبوع الماضي، احتدم الجدال بمواقع التواصل حول مسيرة القادمين من آيت بوكماز ونواحيها. المنطقة المشهورة بجبالها وثلوجها شتاء، تحرك أهلها صيفا ورفعوا أصواتهم بعد صمت طويل..
البعض كان يتحدث عن الطبيعة الجبلية الخلابة، ويحصي السياح الزائرين، ويثرثر عن أجمل بلد في العالم.. وأغلبهم لم يصعدوا الجبل يوما، ليكتشفوا كيف هي الحياة خلف تلك الصور السياحية الجميلة.. فليس من رأى كمن سمع.
ولئن كان أهل آيت بوكماز قد تجمعوا وتحركوا، ليطالبوا بإصلاح طريق.. فإن المئات من جيرانهم وراء الجبال ما زالوا يعيشون متباعدين، دون أن يجدوا لا طريقا ولا نصف طريق، ولو ليوصلهم حيث يمكنهم جلب شيء من الماء إلى أكواخهم النائية..
في صيف قائظ، قبل 21 سنة، انتقلنا إلى قرية آيت امحمد من أزيلال، بعدما أفرغتنا من جوفها الحافلة القادمة من البيضاء.. كانت غايتنا من الرحلة، التي نظمتها “جمعية هواة الأطلس” بسيدي عثمان، هي اكتشاف مناطق وراء الجبال لا يصلها “اكحل الراس”.
في ليلتنا الأولى بالقرية، كان لنا لقاء مع جمعويين. وأذكر أن كلامهم أصابنا بحالة ذهول، حينما أخذوا يتحدثون عن معاناة الناس هناك، حتى أنهم لم يدعوا لنا مجالا لقول أي شيء، خصوصا بعدما رسموا صورة قاتمة لما ينتظرنا بالقرى والمداشر البعيدة..
في الصباح، انتقلنا نحو زاوية أحنصال.. السيارات التي أقلتنا كانت من نوع “لاندروفر” قديمة، ليس بها لا شاشات ولا مكيفات ولا حتى نوافذ يمكن إغلاقها بإحكام.
كان المقطع المبرمج للمشي على الأقدام يمتد إلى مضايق تنغير.. المسافة بعيدة، لكنها مفيدة للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة بأجسامنا..
إذا لم يكن لديك ساقان من فولاذ فعليك أن تنسحب وتعتذر.. بل وتطلب الصفح من سكان الجبل عن ما اقترفه في حقهم لسانك أو أزرار حاسوبك.
من زاوية أحنصال، بدأت المسالك تضيق، فتحركنا الواحد خلف الآخر صعودا ونزولا بين الجبال. كنا نسير 8 إلى 9 ساعات في اليوم، حيث ليس ثمة إلا شبه حياة، لا طائر يطير ولا وحش يسير، ما عدا سنجابا صغيرا ظهر واختفى بسرعة بين الأحراش.
المغامرة لا ينصح بها من ألف السيارة والمكتب المكيف، وهي تشبه الخضوع لتدريب عسكري في العصر الوسيط.. أما قطع الحجارة الجبلية المتناثرة بالطريق الوعرة فإنها إذا لم تصب كاحلك تعيق حركتك. ولولا الأحذية الجلدية الطويلة لما استطاعت أقدامنا المضي ولو لـ10 أمتار.
كانت ثلاثة بغال تحمل أمتعتنا، فيما كنا نحمل الماء فقط، وعلينا أن لا نضيع أي قطرة، فالوصول إلى عين أو بئر قد يتطلب ساعات من المشي. ولعل حظنا كان أفضل من المشاركين في الرحلة السابقة، والذين قضوا يوما كاملا بين الجبال، بعدما أضاعوا الطريق ونفد منهم الماء.
وراء تلك الجبال، عشنا أربعة فصول في يوم واحد، وكنا نجد في ذلك مشقة ومتعة، أما أصحاب البغال الثلاثة فلم تبد عليهم أي علامة من علامات السعادة.. وقد خجلنا من أنفسنا لما صادفنا أطفالا حفاة لفحت الشمس وجوههم، ورجالا ينتعلون نعالا تظهر منها أخاديد بمؤخرة أقدامهم.
أحد مرافقينا كان قد نبهنا لنأخذ معنا بعض الحلويات لأجل الصغار. الأطفال الذين بدت شفاههم مشققة (ربما نتيجة رحلات البحث عن الماء) تشك إن كانوا يستطيعون التعرف على باقي المغاربة.. حينما تجدهم بجانب أحد الأكواخ، يبادرونك بكلمات استجداء فرنسية أو إنجليزية.. فتدرك أن أكثر المترددين عليهم فقط من ذوي البشرة الشقراء، الذين يأتون للمتعة والاكتشاف..
عندما عثرنا على جدول ماء، بعد أيام، فرحنا واغتسلنا ولعبنا مثل أطفال.. أما أهل الجبل فهذه بالنسبة إليهم ثروة لا تقدر بثمن، ولا مجال للعب بمادة هي أهم شيء للبقاء على قيد الحياة. والصغار أيضا يدركون ذلك فيقطعون الكيلومترات من أجل ملء قنينة من سعة خمسة لترات..
عند مغادرتنا للمنطقة، وجدنا أحد الآبار القليلة في طريقنا، فملأنا القنينات المعلقة برقابنا، ثم انصرفنا وتركنا خلفنا طفلين في سن التمدرس وهما يحاولان نقل قنينتين ثقيلتين، فيما لا يبدو في الأفق أي أثر لمسكنهما.. ودعناهما وتابعنا السير. والله أعلم بحالهما الآن، فلربما كانا من المشاركين في مسيرة أهل الجبل بعد زيادة عقدين في عمرهما.