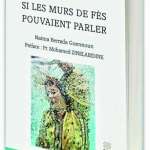دأبت مدينة فاس، طيلة تاريخها، على إيواء وتقديس أوليائها، فسكانها كانوا دائما يعتبرونهم شخصيات استثنائية وذات قدسية. وكعرفان بجميل صنيعهم، وتأكيدا لمكانتهم الروحية، كانوا يعمدون دائما إلى تزيين وتنميق قبورهم، لإعطائهم نوعا من الحياة بعد الموت بتحويلهم إلى أمثلة يجب اتباعها على المستوى الروحي. هكذا سيتحلق المريدون من كل الأحياء حول تلك الأضرحة، مرسخين تقليد اللقاءات وعادة حلقيات الذكر والمواسم.
موازاة مع مهمتها الروحية، كانت الأضرحة تتصدى لمهام أخرى: منها حل المشاكل العائلية والمهنية واستقبال طلبة العلم (الطُّلبة)، الذين يقدمون من شتى جهات المغرب. بل وكانت على غرار المدارس، تنهض بعبء تحمل النفقات التي يتطلبها تمدرس وتغذية هؤلاء الطلبة. كانت لا تعدم أن تحصل الموارد اللازمة لذلك، من الهبات والصدقات التي يجود بها السكان.
سلطان الطلبة
زيادة على ذلك، وعند بداية فصل الربيع، كان هؤلاء الطلبة، من الذين تدعمهم هذه الأضرحة، ينتخبون من بينهم من يطلقون عليه لقب سلطان الطلبة. كان يتعين على هذا الأخير أن يطوف المدينة، وأن يمثل أمام الجمهور الفاسي الذي كان يحييه ويهلل له بحفاوة بالغة. كان هذا السلطان المؤقت أو الرمزي يمتطي جوادا أصيلا، ويضع فوق رأسه مظلة مهيبة تمنع عنه الشمس، أهداهما له السلطان المغربي.
كان يحرسه أثناء طوافه خفر مهيب يتكون من زملائه الطلبة. وكان السلطان يهب ليستقبله بقصره فيغمره بالهدايا، ويصدر أوامره المطاعة بتنظيم نزهة على أطراف واد فاس له ولباقي الطلاب. كان هذا التقليد يعكس مدى تقدير فاس للعلم ولطلبته.
كان المكلفون بتسيير الأضرحة، مستشارين من نوع خاص، يسعى الناس إلى أخذ رأيهم في حل بعض النزاعات وأشياء من هذا القبيل، قبل التوجه لدى القاضي.
كان الغرض الأساسي من وجود الأضرحة وانتشارها هو تقديم خدمات للسكان، سواء على مستوى توفير التعليم الديني لهم، أو على مستوى دعمهم ماديا ومعنويا.
وكان المتعاطفون رجالا ونساء، من العلماء والحرفيين والتجار والموظفين، يتبرعون بمختلف العطايا والمنح لهاته الأضرحة، مما كان يسمح لهذه الأخيرة أن تستغل هذه الموارد النقدية والعينية في تمويل تسييرها الذاتي وتلبية حاجات المعوزين. إذ كان يقع مرات عديدة، أن يتم التكفل باليتامى والطلبة، ولم لا حل أزمات بعض التجار من الذين يعانون من ضوائق مالية لمساعدتهم على تجاوزها. كان المجتمع آنذاك متلاحما متراصا كالبنيان المرصوص، وكان العمل التضامني هو القاعدة التي لا محيد عنها عبر كل أرجاء بلادنا. كانت الدولة من جهتها تلعب دورا اجتماعيا كذلك، عبر مؤسسة الأحباس، مخضعة في الآن نفسه الزوايا لمراقبة مستمرة.
يجدر بنا القول إن هذه التقاليد، التي هي خاصية مميزة لبلدنا، كانت تمثل نهجا أصيلا وفعالا لضمان وحدة المغرب، كما أنها لم تكن بالضرورة مجافية لتعاليم شريعتنا السمحاء، إذا ما استثنينا بطبيعة الحال ما كان يضفيه بعض الجهلاء أحيانا على الزوايا من قدرات خارقة ومعجزات وكرامات لا يصدقها العقل.
لا أخفيكم أنني خلال مرحلة طفولتي وبداية شبابي، كنت واحدة من هذه الزمرة الضالة مثلي في ذلك مثل العديد من العائلات. فللأسف، كان قد تم تحريف الدور المهم الذي كانت تلعبه مؤسسة الأضرحة، من خلال نشر بعض الخرافات والأساطير والكرامات الخيالية. لكن ذلك الانحراف لم يمنعها لحسن الحظ من الاستمرار في إسداء خدمات غير مسبوقة في تدبير وتخفيف التفاوتات الاجتماعية.
أسطورة حانوت النبي
كان التوجه لمنزل جدتي يمر وجوبا بدكان مشهور وغامض يسمى حانوت النبي. ولأنه كان مقفلا باستمرار، فقد قرر يوما بعض الأطفال أن يستقروا في درجه، كي يلعبوا بنوى المشمش لعبتهم المفضلة المسماة «الملا».
حين رأيتهم أول مرة، عجبت لجرأتهم تلك، حيث لم يخفف من دهشتي الكبيرة مما اقترفوه من إثم سوى قيام مالك الدكان المقابل للحانوت بنهرهم وطردهم من المكان.
كانت التربية «القويمة» تفرض علينا أن لا نناقش العادات والتقاليد المتجذرة، حتى لو ظهر لنا أنها منافية للمنطق ومجافية للعقل. فقد درجنا على احترام كل الموروث صحيحه وسقيمه.
هكذا توقفت مع الجميع، وبدأت أقلد ما كنت أرى الكبار يفعلونه: رفعت يدي إلى السماء أستقطر الرحمة الربانية، وأتلو بعضا من الأدعية السرية الخاصة بي، والتي لا أطلع عليها أحدا. ثم جلست بدوري لأرتاح وألتقط أنفاسي، قبل صعود العقبة شديدة الارتفاع لزقاق الرمان التي كانت قبالتي. لكن فجأة يبتسم لي الحظ وأكتشف، بفضل مرور بعض بنات عمي، ممرا سريا، يختصر علي الطريق التي كانت بانتظاري. كانت هذه الطريق طريقا مختصرة جدا تشبه الركوب فوق بساط الريح لعلاء الدين.
أخيرا عرفت أن مدينتنا تتوفر على أنفاق تحت الأرض، بـ«عقبة الفيران»، وسيدي أحمد الشاوي.. كان المشي داخل المدينة عبارة عن متعة لا تضاهى، كما كان مليئا بالاكتشافات، لكن صعود طفلة مثلي لتلك العقبات لم يكن أبدا بالأمر الهين أو السهل.
كنت أحب الجلوس على درج حانوت النبي، خصوصا وأن الشاب صاحب محل التحف، كان قد قرر أن يخصني بمعاملة مختلفة، بعد أن آنس براءتي المعلنة وتركني على سجيتي. كنت أفرح بموافقته على جلوسي هناك، وهي الموافقة التي كان يؤكدها لي بإيماءة من رأسه مع إرفاقها دائما بابتسامة عريضة. فالواضح أنه كان يشعر أنه مكلف بمهمة، أو بالأحرى أنه صاحب رسالة، وأن الله سبحانه قد قيضه لحراسة ذاك «المعبد». أنا أيضا كنت مثله، ولكن بطريقتي: كنت أشعر بضآلتي أمام شخص مهم من وزنه، وكنت أحس أني مميزة وأستحق مباركة السماء لي نظرا إلى إخلاصي لعقيدتي. كنت أحسب هذا الإخلاص كاملا ومنسجما مع مبادئ الدين الصحيح، كما كنت أتبينها بفهمي المتواضع آنذاك، ومما كان يرشح بذهني من تصورات أو إملاءات للآخرين.
لم يلبث هذا الرضى عن النفس أن ازداد وتقوى في اليوم الذي سوف ستنفتح فيه على مصراعيها أبواب ذاك الحانوت. كان الوقت يصادف وقت قدوم الليل، وكنا نحن عائدين من بيت جدتي، وإذا بأمي التي كانت تصطحب معها كعادتها جميع أبنائها، تتفاجأ بوجود شخص قد استقر في وسط حانوت النبي، وهو يجَوِّد بصوت حسن ورخيم القرآن الكريم. انتظرته أمي في خشوع تام أن ينهي قراءته، ثم بادرته قائلة له بأدب جم: «سيدي الفقيه، هل لك لو سمحت أن تبارك ابني هذا الذي يشكو بانتظام من لوزتيه ومن الحمى».
اغتنمت فرصة حديثهما، وجلت بعيني داخل المكان، باحثة عن قبر سيدنا النبي، ولما لم أجده، وجهت كل تركيزي نحو ذاك الشخص، قمت بتقبيل يديه بحماس كبير، فقام هو أيضا بمسح رأسي ورأس شقيقتي وأخي الأصغر بيده. شعرت حينذاك أن طاقة إيجابية قد اخترقت بدني. كان شعورا فريدا من نوعه لم أجربه من قبل، لكنه سرعان ما سيتبدد هباء منثورا، ما إن لمحت أمي تنفحه بعض النقود.
بعد ذلك، سأعلم أن السلطات قد قررت إغلاق ذاك المكان بقرار لا رجعة فيه: فقد حجت إليه وفود غزيرة، نتيجة نجاح هذا الفقيه في استغلال سذاجة السكان وتماديه في ذلك.
منذ ذاك اليوم، بدأت مكانة ذاك المكان، الذي كنت أظنه مقدسا، تهتز وتتلاشى تدريجيا بداخلي إلى أن ذوت هالته نهائيا، وفقد كل تأثيره الروحاني على الطفلة الصغيرة التي كنتها.
عقودا بعد ذلك، وخلال مراسيم العزاء في خال والدي الحاج عبد القادر، سأعرف أنه كان هو المالك المتخفي لذاك الدكان العجيب. هكذا ستدق ساعة الحقيقة، وسيتم إفشاء سره الدفين، إذ سأعلم أن الأمر يتعلق بحلم أو رؤيا مفادها أن «سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام قد مر من ذاك الدكان».
كان ذاك الحلم إذن هو من حول ذاك الدكان إلى مكان مقدس.
لكن حانوت النبي لم يكن المكان المقدس الوحيد بتلك الناحية، فعلى بعد عدة عشرات الأمتار منه لا غير، كان يوجد ولي ذو قدسية ووقار خاصين، له الكثير من الأتباع والمريدين، وأغلبهم من الأعيان، كان اسمه سيدي قاسم بن رحمون، لكني كنت أجهل وجوده، إلى أن أتى اليوم الذي ستعرفني بوجوده بنات عمي. كانت توجد لهذا الضريح باب ثانوية تنفتح على زقاق الحجر.
كانت بنات عمي قد قررن زيارته، وطلبن مني الالتحاق بهن، لكي يرشدنني إلى ممر سري سيجنبني أن أصعد تلك العقبة التي تؤدي إلى بيتنا.
لم أتذكر حينها أنه قد سبق لي رؤية قبر هذا الولي، لأني كنت مشغولة بمعية أبناء خالتي بالبحث عن قبر والدهم، الذي كان قد انتقل إلى رحمة الله وهو بعد في ريعان الشباب؛ كنا ندعوه عمي أحمد. كان في مثل عمر والدتي، وكان محبوبا من قبل والدي كليهما، لأنه هو من هيأ ظروف ارتباطهما. كان الكل يترقب وفاته، لأنه كان يعاني مرضا خبيثا في وقت لم يكن فيه الطب قد حقق هذا التقدم المثير الذي هو عليه الآن.
أتذكر جيدا أنني كنت لا أقابله إلا وأحدق مليا في وجهه، لأحفظ قسماته ولأطبع صورته في خيالي، كأني كنت أخمن أن مقامه في الدنيا قصير، سيما وأن الصور الفوتوغرافية كانت في تلك الفترة نادرة جدا.
بمجرد دخولنا إلى الضريح، شرعنا في النزول عبر سلسلة من الأدراج، لنجد أنفسنا في قبو كبير ومظلم يعج بقبور الموتى. في تلك الفترة كانت بعض المقابر تتوسط المدينة. وكان تزيينها بفسيفساء ملونة يجعلها أقل رعبا ووحشة، بل ويحيلها في نظرنا لمكان مألوف.
زد على ذلك، أن الأطفال كانوا معتادين على الذهاب إليها. وهو الأمر الذي خلق بينهم وبينها معرفة راسخة وواضحة. هذه المقابر ملاصقة في أغلبها للمساجد القريبة من محلات إقامتنا.
ضريح تحت الأرض
كان البحث عن الممر الثاني، لأجل مغادرة ذاك الضريح، تجربة مزعجة لنا للغاية، أو لأقل إنه كان أقرب إلى كابوس مرعب، فقد ضللنا الطريق وبقينا ندور في مكاننا على غير هدى، خائفات وجلات في شبه حلقة مفرغة، كأننا نخوض عباب متاهة مظلمة لا نهاية لها. في كل مرة كانت تومئ فيها إحدى بنات خالتي إلى منفذ مفترض، نكتشف أننا في الاتجاه الخطأ، فتنشط مخيلاتنا الخصبة مباشرة بعد ذلك في رفع منسوب الخوف فينا. ثم ما لبثت إحداهن في غمرة الظلام أن داست برجلها على ذيل قط، فكان مواؤه الحاد المحتج على إقلاق راحته عاملا إضافيا ضاعف هواجسنا، التي صارت غولا يطل علينا بسبعة قرون.
لحسن الحظ، أن طفلا صغيرا كان موجودا هناك، سيتطوع ويقوم بنجدتنا وانتشالنا من ورطتنا. لم نعرف أية أقدار قيضت لنا هذا المخلص الصغير الذي دلنا على الطريق، ثم اختفى مباشرة لكأنما بلعته الأرض. لقد كانت القاعدة الذهبية في تلك الفترة هي الفصل التام بين الجنسين، ولو تعلق الأمر بأطفال لم يبلغوا الحلم. لكم أن تتخيلوا مقدار سعادتنا لما أصبحنا خارج الضريح، وكيف كان مقدار فرحتنا حين تنفسنا الصعداء أخيرا. لا أخفيكم أننا انطلقنا حينها كما ينطلق أسرى غادروا الحبس للتو.
كان اكتشاف الضريح مفاجأة رائعة لنا، لكنني لم أفكر بعد ذلك في زيارته مرة أخرى، رغم أنه كان يستقطب إليه الكثير من المريدين، ومن ضمنهم جدي لوالدتي سي ميكو، الذي كان صديقا للمدير المقدم سي التازي الذي تطوع لتسيير الضريج، وكان بالمناسبة تاجرا كبيرا للحرير.
ستحكي لي أمي يوما: «والدي ينتسب لهذه الطريقة. لذلك هو يتردد كثيرا على الضريح للقاء أصدقائه الذين يوجد من بينهم الشرفاء الوزانيون، وعالم كبير يدعى الفقيه مزور. هذا الفقيه هو من يتولى تأطير المريدين، إضافة إلى كونه من حرر عقد زواجي». سألتها بسذاجة متناهية: «لماذا لا يكتفي جدي باستقبال أصدقائه بمنزله؟». جعلها سؤالي تسهب في شرح الدور الاجتماعي والروحي للأضرحة قائلة: «الزاوية هي صنف من المساجد، حيث نصلي ونتعبد، وحيث يستقبل الحكماء الكثير من الناس، ويفضون العديد من النزاعات التي تنشب بينهم كنزاعات الطلاق والميراث إلخ، كما أنها تعمل على مساعدة الفقراء والمحتاجين… بل وقد تنتصب طرفا في حل الخلافات المهنية…». أردفت ملاحظة: «أمقت ان أرى الكبار يتخاصمون». أجابتني على التو: «من المحتمل جدا أن يقع ذلك، لكن المهمة الأولى للزاوية هي أن توفر التعليم والتأطير لكل أولئك الذين يودون تعميق مداركهم في الشريعة الإسلامية. جدك يستفتي بانتظام الفقيه مزور، لفهم وتأويل ما استعصى عليه من نصوص دينية. في المقابل جدك الآخر وأبوك يستشيران العالم الشهير سيدي إدريس العراقي، شقيق المرحومة جدتك لوالدك، والذي يقعد بالزاوية التيجانية».
كان العلماء يهدون الناس، وينيرون لهم الطريق، وكانوا ينكبون أيضا على علاج الحالات الاجتماعية. كانوا وسطاء بين من يملكون ومن لا يملكون، فيدفعون الأولين إلى مساعدة هؤلاء بشكل مباشر.
أعلمتني والدتي خلال ذاك الحديث الذي دار بيننا: «كل عائلة تملك لائحة محتاجين تخصص لهم عطايا عند نهاية كل أسبوع. يمكن أحيانا أن يتم شراء منزل لهم، أو التكفل بنفقات تمدرس أبنائهم، أو أداء مصاريف علاج عضو من أسرتهم. لكن التستر واجب في مثل هذه الحالات، حتى لا نشعرهم بالضيق أو بالانزعاج».
حقيقة، كانت الزوايا والطرق الصوفية تلعب دورا حيويا في تدبير وتخفيف حدة التفاوتات الاجتماعية. بعض هذه الزوايا تجاوز إشعاعه المغرب ليصل إلى كثير من الدول العربية والإفريقية، كالزاوية القادرية والزاوية التيجانية غير البعيدة عن جامع القرويين. حين زرت منذ مدة غير بعيدة القدس الحبيبة بفلسطين، كنت قابلت إمام مسجد الصخرة، وقد اندهشت بالخصوص لما أخبرني أنه من أتباع الطريقة التيجانية، بل وصديق لأحد أعمامي. فقرأنا معا صلاة الفاتحة التي كان جدي قد حفظها لي، ثم دعونا لكل المغاربة والمسلمين. أطلعني الإمام أيضا على كون الحرفيين المغاربة كانوا الأمهر والأحذق خلال عمليات إصلاح وتأهيل الأماكن المقدسة، وزاد أن الزرابي الرباطية المغربية، الممنوحة من طرف سلاطين المغرب، هي من تزين مسجد الصخرة.
شكل ذاك الحوار المقتضب بالنسبة إلي لحظة تفاعل وتقاسم فريدة من نوعها، عشتها بكل جوارحي في ذاك المكان الروحاني الذي تحفه العناية والألطاف الإلهية.
كان لكل حي بالمدينة ولي يحظى بالإجلال والتوقير. كان الوليان الموجودان بحينا هما سيدي أحمد الشاوي، وسيدي أحمد بناصر.