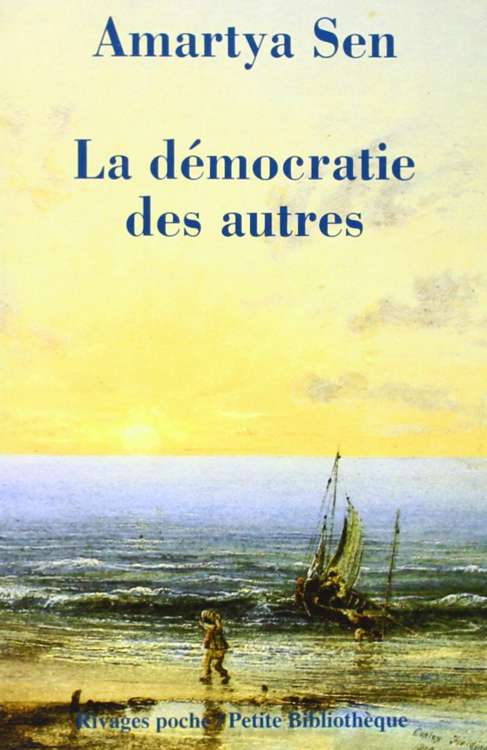الغرب ليس النموذج الوحيد والأوحد للديموقراطية
كتاب «ديموقراطية الآخرين» لـ«أمارتيا سين»

يطرح كتاب «ديموقراطية الآخرين» إشكالية جدية تتعلق بمختلف الأشكال والصيغ غير الغربية للديموقراطية، ونقصد أمما كثيرة غير غربية لها نموذجها الخاص في الدمقرطة. نتحدث هنا عن نماذج لا تلقى في الأوساط السياسية والإعلامية الغربية ترحيبا كاملا، كباكستان وإيران والبرازيل وروسيا ومصر، ولكل دولة من هذه الدول نموذجها الخاص. فإن كانت الديموقراطية هي تمثيل الأمة في المجالس المنتخبة واحترام صناديق الاقتراع، فإن الدول السابقة ديموقراطية، لكن لماذا يفرض الغرب الاعتراف بذلك؟ هل الديموقراطية نموذج واحد أوحد، ونقصد النموذج الغربي؟ وهل الدول الغربية نفسها تتبنى نموذجا واحدا؟ لماذا تتسامح الدول الغربية مع تنوع تجاربها وتنكر ذلك مع ما عذاها؟
مساءلة المركزية الغربية من جهة السياسة
هل الديمقراطية كونية، كما هي قوانين الفيزياء النيوتونية؟
قد يكون هذا هو السؤال الذي يحاول الاقتصادي الهندي أمارتيا سين الإجابة عليه في هذا الكتاب القصير، «ديمقراطية الآخرين». لماذا لا تُعتبر الحرية من اختراع الغرب؟ يجمع هذا المقال بين محاضرة أُلقيت في نيودلهي سنة 1999 (ونُشرت في العام نفسه في مجلة الديمقراطية) ومقال نُشر سنة 2003 في مجلة «ذا نيو ريبابليك» («الديمقراطية كقيمة عالمية»)، ويسعى إلى دحض الفكرة السائدة، والتي يرى المؤلف أنها شائعة جدًا، والتي مفادها أن أصل الديمقراطية يكمن في الحضارة الغربية. ويهدف هذا العمل صراحةً إلى معارضة الافتراض القائل بأن «جذور» الديمقراطية لا يمكن العثور عليها إلا «في السمات المميزة للفكر الغربي الذي ازدهر فقط في أوروبا – وليس في أي مكان آخر – ولفترة طويلة جدًا».
من خلال هذا المسعى، الذي لا يقتصر هدفه على التخمين، يهدف الفائز بجائزة ألفريد نوبل في الاقتصاد لعام 1998 إلى المساهمة في «التحدي الأكبر في عصرنا»، ألا وهو دعم النضال «من أجل نموذج ديمقراطي عالمي».
في هذين النصين، يتبع أمارتيا سين مرارًا وتكرارًا نفس المسارات للرد على ما يعتبره، في رأيه، الاعتراضين الرئيسيين اللذين يُثاران كثيرًا ضد النموذج الديمقراطي.
أولًا: يعارض المؤلف فكرة أن الديمقراطية غير مناسبة لأفقر البلدان، بحجة أن ما تحتاجه هذه البلدان ليس الانتخابات، بل الخبز. بالنسبة لمؤيدي ما يُطلق عليه المؤلف «فرضية لي» (التي سُميت تيمنًا باللي كوان يو، رئيس الوزراء ووزير الدولة السابق لسنغافورة بين عامي 1959 و1990، والذي كان من أشد مؤيديها)، فإن النظام الاستبدادي، بدلًا من نظام حكم الشعب، هو الأقدر على ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية للسكان المحتاجين، وبالتالي المساهمة في تنميتهم الاقتصادية. ويعارض أمارتيا سين هذه الرؤية بنماذج الهند وجامايكا وكوستاريكا.
ففي إطار الأنظمة الديمقراطية، نجحت هذه الدول الثلاث في الحفاظ على معدل نمو اقتصادي يحسدها عليه جيرانها. ولكن الأهم من ذلك، أن دحض هذه الفرضية يُتيح للمؤلف أيضًا فرصةً لتحدي فكرة وجود أي علاقة بين النظام الديمقراطي والنمو الاقتصادي. ويعتمد الكاتب على فرضية شرحها بإسهاب في كتابه «نموذج اقتصادي جديد». في كتابه «التنمية، العدالة، الحرية» أوديل جاكوب سنة 2000، حيث يُجادل هذا الاقتصادي من جامعة هارفارد بأنه لا يمكن الجزم بوجود علاقة سببية بين الديمقراطية والنمو الاقتصادي: «إذا قورنت جميع الدراسات المقارنة، فإن فرضية عدم وجود علاقة واضحة بين النمو الاقتصادي والديمقراطية في أي من الاتجاهين تظل معقولة للغاية». وبالتالي، فإن إرساء الحقوق السياسية الديمقراطية في مجتمع ما قد لا يكون له أي تأثير على تنميته الاقتصادية، سواءً كان إيجابيًا أم سلبيًا. فالديمقراطية شيء، والتنمية الاقتصادية شيء آخر.
ثانيًا، يسعى أمارتيا سين إلى دحض الفرضية القائلة بأن الديمقراطية غير مناسبة لبعض الثقافات، لأن هذا النظام غريب عنها بطبيعته. ووفقًا لرأي شائع إلى حد ما، فإن «الاختلاف الثقافي» من شأنه أن يُبرر حصر ممارسة الديمقراطية في الغرب. وبالتالي، فإن أي جهد لدعم هذا النظام السياسي في الدول غير الغربية لا يُعدّ إلا شكلاً من أشكال التغريب، أي محاولة لفرض هذا النظام الغربي – من خلال الترويج لطابعه العالمي المزعوم – على بقية العالم. وللرد على هذا الاعتراض الثاني، لا خيار أمام الكاتب سوى التأمل في طبيعة الديمقراطية.
الديموقراطية.. التدبير العمومي للاختلاف
يرى أمارتيا سين أن الديمقراطية لا تقتصر على بُعدها الوظيفي فحسب، أي إجراء الانتخابات. مستلهمًا تحليل الفيلسوف الأمريكي الشهير راولز، حيث يطرح الكاتب مفهومًا للديمقراطية كممارسة اجتماعية، ألا وهو «ممارسة العقل العام». وبالتالي، يمكن تحديد ديناميكيتين في صميم هذه الممارسة الاجتماعية: «التسامح مع وجهات النظر المختلفة (بما في ذلك الاتفاق على الاختلاف)» و«تشجيع النقاش العام (بما في ذلك التمسك بفكرة إمكانية الإثراء والتعلم المتبادل)».
بناءً على هذا التعريف للديمقراطية، يواصل سين تأملاته ويتساءل عن مدى اعتبار هاتين الممارستين الاجتماعيتين سمتين خاصتين بالغرب. يبدأ الجواب على هذا السؤال بدحض أسطورة وجود تسامح غربي نموذجي، والذي ينبغي معارضته بـ«استبداد غير غربي». يستذكر المؤلف كيف كانت القاهرة، في عهد صلاح الدين الأول مدينةً يسودها التسامح، ويشهد على ذلك لجوء المفكر موسى بن ميمون إليها هربًا من أوروبا التي كانت آنذاك متعصبة تجاه اليهود. وبالمثل، تُعدّ الأندلس، في عهد خلافة عبد الرحمن الثالث، الذي تولى وزارته يهودي يُدعى حسداي بن شبروط، أو حتى إمبراطورية المغول في عهد أكبر في نهاية القرن السادس عشر، حيث عاش المسيحيون والبارسيون والجاينيون واليهود بسلام، أمثلةً قاطعةً على ممارسة التسامح السياسي خارج العالم الغربي.
ويذكر المؤلف أنه في أوروبا، في عهد أكبر، أُحرق جيوردانو برونو بتهمة الهرطقة! لذا، يرى أمارتيا سين أنه من المهم أولًا التأكيد على أنه لا يوجد استثناء غربي في ما يتعلق بالتسامح والحوار. في حين أن التسامح لا يمكن أن يكون حكراً على الغرب، فإن تشجيع النقاش العام يجد أمثلة عديدة خارج العالم الغربي. ويستشهد بتجارب الهند والصين واليابان، وهي ثلاث دول تُمارس فيها الحوكمة منذ زمن طويل من خلال «جمعيات عامة، مفتوحة للغاية، تهدف تحديداً إلى حل النزاعات الناشئة عن اختلاف وجهات النظر».
الديموقراطية ديموقراطيات
يذكر المؤلف الطبيعة العامة للمجالس التي عُقدت في باتاليبوترا (باتنا حالياً)، الهند، في القرن الثالث قبل الميلاد. وبالمثل، يُمثل تطور دستور المواد السبع عشرة في اليابان عام 604 ميلادي، في عهد الأمير شوتوكو، مثالاً بارزاً على ممارسة النقاش العام في العالم غير الغربي. هذه التجارب – التي تعود أصولها، وفقاً للمؤلف، إلى «المجالس البوذية التي عُقدت بعد وفاة غوتاما بوذا بفترة وجيزة» تُفند بوضوح، في رأيه، الوجود الحصري للنقاش العام في الغرب. باختصار، يُمثل هذا العمل الموجز تأملاً مُلهِماً في طبيعة الديمقراطية، ويُتيح لنا تقدير سعة اطلاع الاقتصادي الهندي. ومع ذلك، ودون التقليل من أهميته، يُثير هذا التأمل بعض التساؤلات. لذا، لدعم دحضه لفكرة أن التسامح قيمة غربية أصيلة، وأن التعصب أمرٌ ينتمي إلى الشرق، ألم يكن من الأجدى التذكير بأنه باسم المُثُل السياسية المُستوردة من الغرب، بدأت دولٌ مثل فيتنام والصين وكمبوديا تُمارس بعضاً من أشد أشكال التعصب السياسي تطرفاً التي عرفتها البشرية؟ علاوةً على ذلك، وفي سعيه لدحض مسألة الاختلاف الثقافي لتفسير الطابع الغربي للديمقراطية، يرى المؤلف ضرورة تحذير القارئ من خطر رؤية ثقافة واحدة متجانسة في قارة آسيا الشاسعة، وبالتالي إهمال مراعاة التنوع الشديد للثقافات التي تُشكله. أليس من اللائق أن يحترم المؤلف هذه النصيحة الثمينة عندما يتناول مسألة ممارسة الديمقراطية في إفريقيا؟ كيف يُمكن، بصراحة، الحديث عن وجود «فكر ديمقراطي في إفريقيا»؟ وكأن هذه القارة الشاسعة، وتنوعها الثقافي الهائل الذي يزدهر فيها، تُشكل تجربة ثقافية وتاريخية واحدة ونموذجية أيضا؟
فبالاعتماد على التجارب التاريخية من الهند والصين واليابان ومنغوليا وإفريقيا، يُظهر المؤلف أن سمات الديمقراطية وُجدت في مناطق خارج ما يُعرف عمومًا بالغرب. ويؤكد أن هذه التجارب التاريخية، علاوة على ذلك، لا تمت بصلة إلى التاريخ الغربي إطلاقًا. بل إنه يُجادل بأن بعض هذه التجارب حدث عندما كانت أوروبا، مهد هذا الغرب المُمجّد، أرضًا يسكنها البرابرة، وتعتمد في تنظيمها على علاقات القوة فقط.
قد يقول بعض المفكرين السياسيين، الذين يسارعون إلى الاستناد إلى دراساتهم الكلاسيكية – الهيلينية والرومانية واليهودية المسيحية – لإثبات أن الديمقراطية وُلدت ونشأت في أوروبا، وفي أوروبا وحدها، إن هذا تجديف. هل هو خلاف بين المؤرخين؟ ربما. ولكن لكي يكون لهذا الخلاف أي معنى، يجب تحديد مصطلحات النقاش بوضوح. ماذا نعني بالديمقراطية؟
إن إجابة سين هي ما يجعل حجته مثيرة للاهتمام، متجاوزةً المتعة التي قد يجدها القارئ في اجتياز قرون وقارات لاكتشاف تجارب سياسية غير متوقعة. يُقارن سين تعريف الديمقراطية الذي يُركز على مسألة التصويت والانتخابات بتعريفٍ لخّصه الفيلسوف رولز بأنه «ممارسة العقل العام».
يؤكد رولز: «في نهاية المطاف، المفهوم الأساسي للديمقراطية القائمة على التشاور هو مفهوم النقاش نفسه. فعندما يناقش المواطنون، يتبادلون الآراء ويناقشون أفكارهم الخاصة حول القضايا العامة والاقتصادية الرئيسية». والانتخابات ليست سوى وسيلة لتمكين هذا النقاش العام، الذي يُمثل في نهاية المطاف جوهر الديمقراطية.
وهكذا، فإن التجارب الشمولية، التي تعتمد على أنظمة انتخابية، ليست ديمقراطيات، في حين أن أشكال التنظيم السياسي التي تسمح بالتمثيل والمواجهة السلمية للمصالح والآراء والثقافات المختلفة دون الحاجة إلى النظام الانتخابي الكلاسيكي، تُقارب ما يُسمى بالحكومة الديمقراطية.
هذه الفكرة، التي تقضي بأن الحكم الرشيد لا يمكن أن يقوم إلا على نقاش مفتوح وحر بين مختلف الكيانات، راسخة عبر التاريخ. ما يميز الحداثة هو التطور الهائل لهذه الفكرة عالميًا وتطبيقها العملي في الغرب، بالتأكيد، ولكن أيضًا في مناطق أخرى من العالم.
ومع ذلك، لا يمكن تحقيق تقدم الفكرة الديمقراطية إلا على أساس تعريف صحيح لهذا المفهوم. إن الاستمرار في الاعتقاد بأن الديمقراطية غربية، غربية ثقافيًا، وأنها يمكن تلخيصها في نظام انتخابات حرة، هو قبول بأن مناطق معينة من العالم تنزلق إلى الاستبداد بعد تصويت «ديمقراطي» (فلسطين، إيران، معظم إفريقيا السوداء، إلخ) ليست مناسبة للديمقراطية، وربما لن تكون كذلك أبدًا.
إن قبول أن الديمقراطية هي، قبل كل شيء، «ممارسة للعقل العام» يمنح هذه الديمقراطية نفسها فرصة التطور في جميع أنحاء العالم؛ ويسمح لها بالبقاء مفهومًا عالميًا.
ففي ضوء الأحداث الجارية، من العراق إلى أفغانستان، ومن الصومال إلى السودان، لا يسع المرء إلا أن يتفق مع كلمات سين. إن الديمقراطية مفهوم عالمي، ولكن لا بد من تعريفها بدقة لفهم التحولات اللازمة لتطورها.