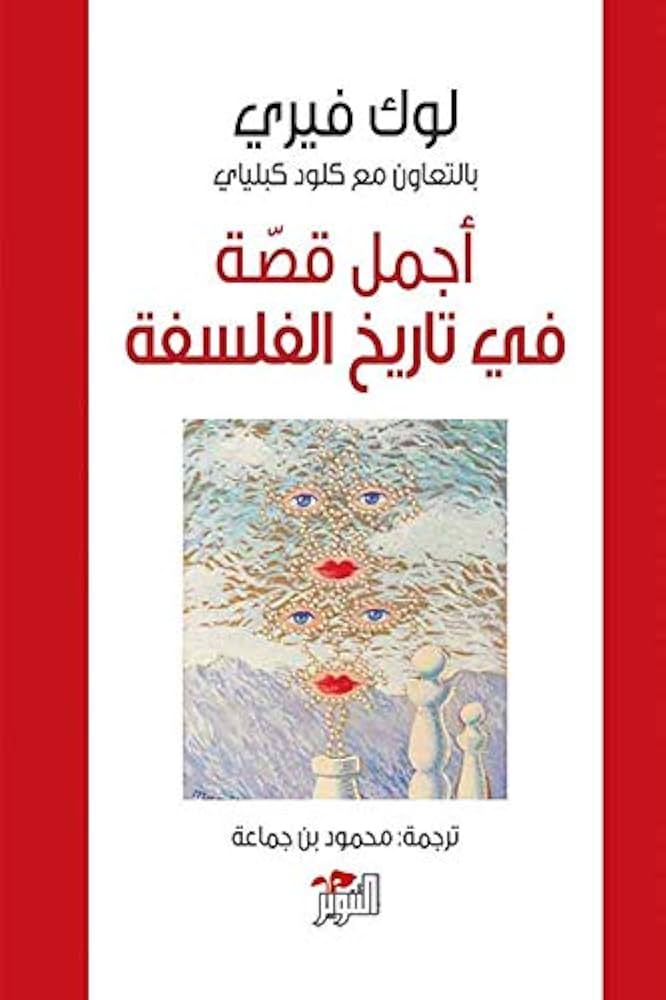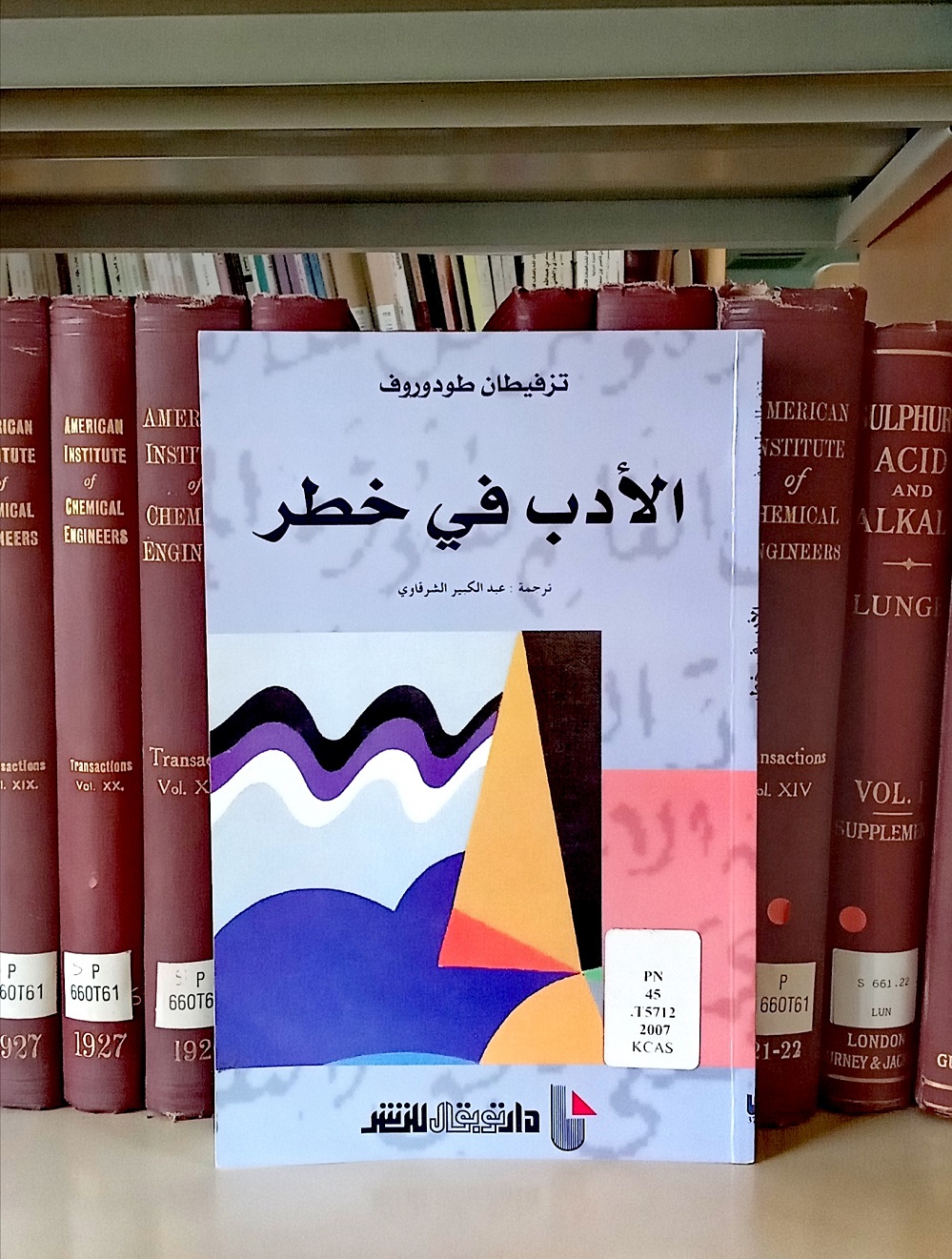إعداد وتقديم: سعيد الباز
لعلّ أهم ملامح الحصيلة الثقافية ومحطاتها الكبرى لسنة 2025، من خلال جائزة «نوبل» للآداب وجائزة «غونكور»، تتجلّى في الحضور الأوروبي البارز، وأظهرت، كذلك، أهمية الترجمات المتعددة والأكثر حضورا في حسم نتائج جائزة «نوبل» للآداب، أو دور النشر وحجم الانتشار الإعلامي في اختيارات جائزة «غونكور». هذه السنة شهدت، أيضا، رحيل صنع الله إبراهيم وماريو فارغاس يوسا، اللذين شكّلا أحد رموز الرواية العربية والرواية في أمريكا اللاتينية.
جائزة نوبل 2025.. لاسلو كراسناهوراكي
أتت جائزة «نوبل» لهذه السنة متوافقة مع الكثير من التوقّعات بفوز الكاتب والروائي المجريّ لاسلو كراسناهوراكي، نظرا لاتّساع شهرته وتداول اسمه في الفترة الأخيرة، عبر العديد من الترجمات في العالم، ما جعل منه ظاهرة روائية بارزة في أوروبا والعالم، رغم صعوبة لغته الروائية وأسلوبه في الكتابة وهوسه الكبير بالخراب والدمار الإنساني ونهاية العالم. كان هذا الفوز، أيضا، نوعا من العودة إلى تقليد روائي أوروبي ذي نفس ملحميّ. لذلك وصفت لجنة التحكيم لجائزة «نوبل»، على لسان رئيسها أندرس أولسون، كراسناهوراكي بأنّه «كاتب ملحمي كبير في التقليد الأوروبي الممتد من كافكا إلى توماس برنارد».
ولد لاسلو كراسنا هوركاي سنة 1954، في بلدة «جيولا» الصغيرة في عائلة من الطبقة الوسطى ذات أصول يهودية. عاش في ظلّ النظام الشيوعي حيث عانى من اضطهاد كبير. هذه المرحلة انعكست كثيرا في أعماله الروائية اللاحقة، وطبعت رؤيته للعالم بالسوداوية الشديدة. رغم سقوط النظام الشيوعي ظل محكوما بأجواء الاستبداد ونظرته التشاؤمية التي استمرّت في مطاردة وجدانه.
لم يكن كرّس حياته، في البداية، لكتابة الرواية بقدر ما كان مهتما بدراساته الفنية والفلسفية بشكل عام، لكنّ تأثير مقولة الشاعر الألماني راينر ماريا ريلكه الشهيرة «غيّر حياتك» كان الدافع الأساسي لكتابة رواية «تانغو الخراب» سنة 1985، التي كانت منطلق مسيرته الروائية الحافلة. أمّا في روايته «الحرب والحرب» فإنّنا نصادف الشخصية الرئيسية جورجي كورين الذي يعمل أمين أرشيف ومؤرخا محليا في إحدى البلدات الهنغارية ويصاب بالجنون. طوال الرواية نراه يقف على عتبة التوصل لاكتشاف مصيري، لكننا لا نتحقق أبدا من حقيقة هذا الاكتشاف.
تصفه الرواية بأنه «لم يكن أساء فهم الحياة وحسب، بل أساء فهم كل شيء عن أي شيء، والأسوأ من هذا وذاك أنه كان يظن، على مدى السنوات الأربع والأربعين الماضية، بأنه يفهم العالم وأمور الدنيا، بينما كان في الواقع قد فشل في ذلك فشلاً ذريعاً، وهذا كان في الواقع أسوأ من كل ما عداه في ليلة عيد ميلاده وهو جالس على ضفاف النهر، الأسوأ لأنه أدرك الآن أن عدم فهمه لم يعنِ أنه لم يكن يفهم ما يحدث الآن، ذلك أن اكتشافه نقص معرفته لم يكن في حد ذاته نوعاً من المعرفة التي قد يعلل النفس بها شخص أكبر منه سناً، إنّما اكتشاف طرح نفسه كلغز مرعب في اللحظة التي فكر فيها في العالم، وهكذا طوال تلك الأمسية لم يكن يفعل شيئاً سوى جلد نفسه بكل قسوة باذلاً كل جهد لديه ليفهم ذلك اللغز لكنه كان يفشل لأن اللغز كان يبدو أكثر تعقيداً وكان قد بدأ يشعر أن هذا العالم – اللغز الذي كان يحاول فهمه بكل ما أوتي من قوة، الذي كان يجلد نفسه محاولاً فهمه، كان بالفعل لغزاً عن نفسه وعن العالم في آن معاً، وهذا ما كان له التأثير نفسه كأنه والعالم أصبحا شيئاً واحداً، ولم يكن قد استسلم لفشله بعد، عندما، بعد يومين من ذلك، لاحظ أن عقله يعاني من خلل ما».
صنع الله إبراهيم.. رحيل روائي استثنائي
يعتبر رحيل صنع الله إبراهيم نهاية جيل كامل من الروائيين الذين مثّلوا حقبة من الانكسارات النفسية والسياسية. جيل حمل على عاتقه أحلاما ورؤى رائدة تدين الحاضر كما تستشرف المستقبل.
غير أنّ صنع الله إبراهيم تميّز، دون غيره من الكتاب الروائيين خلال هذه المرحلة الصعبة والشائكة، بكونه نموذجا متفردا بمساره الروائي المتعدد والاستثنائي، وبأسلوبه الروائي الخاص والمتميّز بلغته ذات النبرة الحادة والغارقة في التفاصيل الدقيقة تستهويه الجمل القصيرة جدا التي تنتهي دوما إلى تشكيل تلك المشاهد التي تصنع عالمه الروائي، يمزج بمهارة فائقة بين الروائي والتوثيقي والتسجيلي كأيّ روائي في ثوب صحافي أحيانا أو سينمائي أحيانا أخرى. لكنّه ظلّ على الدوام ذلك الكائن الوفي لتمرده، والرافض بطبعه، مستقلا وغير مهادن لا يتوانى عن خرق المسلمات السياسية أو الاجتماعية.
كانت تجربة السجن أساسية في حياته وتجربته الروائية عبّر عنها في كتابه «يوميات الواحات» الذي يعتبر سيرة ذاتية، بداية من طفولته وتأثير والده في تكوين شخصيته، وصفة التمرّد التي طبعت حياته وشكّلت معظم مواقفه السياسية والإيديولوجية والأدبية على وجه الخصوص، وتبرز من خلالها قراءاته وكتاباته الأولى، خاصة تجربته السياسية التي قادته إلى الاعتقال في سجن الواحات أثناء الحقبة الناصرية، يقول فيها: «السجن هو جامعتي، ففيه عايشتُ القهر والموت، ورأيتُ بعض الوجوه النادرة للإنسان، وتعلَّمتُ الكثير عن عالمه الداخلي وحيَواته المتنوِّعة، ومارستُ الاستبطان والتأمُّل، وقرأتُ في مجالاتٍ متباينة. وفيه أيضًا قرَّرتُ أن أكون كاتبًا. أما أبي فهو المدرسة. كان حكَّاءً عظيمًا، يُتقِن سبك حكاياته ونوادره المختلفة، النابعة من تجاربه أو قراءاته، بحيث يستولي على مستمعيه.
وكدتُ أُصبِح المستمع الوحيد في السنوات الأخيرة من عمره. فقد كان على مشارف الستين عندما أنجبَني من زوجةٍ ثانية. وخلَق بيننا تقدُّمه في السن، واختفاء أمي المبكِّر، العلاقة الحميمة التي تنشأ عادةً بين الجد والحفيد. كنا نلعب معًا النرد والورق… ثم كان هو الذي شجَّعني على القراءة. وما زلتُ أذكُر الليلة التي عاد فيها إلى المنزل حاملًا ربطةً كبيرة من «روايات الجيب» المستعمَلَة المتنوِّعة…
وكان أبي، مثل الكثيرين من أبناء عصره، متدينًا مستنيرًا، يربط التعاليم الدينية والأخلاقية بالواقع المُستوحَى من تجاربه الواسعة، وبعضها نابع من تنقلاته في أنحاء مصر والسودان بحكم وظيفته المدنية في وزارة الحربية. وآمن في الوقت نفسه بكثيرٍ من الأمور الغيبية وبالسحر والشعوذة. وقد أفادني هذا التناقُض في شخصيته؛ فقد تشرَّبتُ منه احترام الكثير من القيم الدينية السامية، وفي الوقت نفسه كراهية المحتل الإنجليزي والملك والأحزاب الفاسدة، والاستعداد للتمرُّد على الأوضاع والأفكار السائدة، وعدم التسليم بما لا يتفق مع العقل.
دفعَني الملل من الدراسة التي كنتُ فيها متواضعَ الأداء، فضلًا عن ظروفي العائلية، إلى عالم القصص الساحر. ومن حسن حظِّي وحظِّ جيلي من الكُتاب، أن وجَدْنا أمامنا مجلةً أسبوعية تُدعى «روايات الجيب» تصدُر منذ الثلاثينيات، وتنشُر ملخصاتٍ وافية لكافَّة أنواع الروايات العالمية من كلاسيكية إلى بوليسية. وقد أسبغ عليها ناشرها عمر عبد العزيز أمين، ما يتميَّز به من أسلوبٍ عصري بعيد عن التقعُّر. وشاركه في ذلك عددٌ من المترجمين المتميزين مثل شفيق أسعد فريد وصادق راشد ومحمود مسعود وبدر الدين خليل. وصار أبطالي هم «أرسين لوبين» و«روبن هود»، وهم مغامرون رومانسيون، وضحايا للظلم الاجتماعي، ويتميَّزون بالجرأة والشجاعة، وفي أغلب الأحيان يأخذون من الغني ليُعطوا الفقير. شجَّعني أبي على قراءتها، فشُغِفتُ بالروايات البوليسية التي دفعَتني إلى كتابة أولى رواياتي وأنا بعدُ في الثانية عشرة من عمري.
جمعتُ كميةً من الورق المسطَّر ونقلتُ عليه خُفية روايةً بوليسية اسمها «الرجل المُقنَّع» بعد أن غيَّرتُ أسماء الشخصيات ووضعتُ اسمي مكان اسم المؤلِّف الحقيقي. وفي السنة التالية حاولتُ أن أؤلِّف فعلًا رواية عن سرقة مجوهرات، تجري أحداثها في لندن، لم أتقدم فيها أبعدَ من الفصل الأول. كما حاولتُ أن أُترجم بعض القصص الإنجليزية.
في سنة 1950 انتقلتُ مع أبي وأختي الصغيرة من حارة المرصفي بالعباسية إلى شارع السبكي بالدقي قريبًا من كلية الفنون التطبيقية وجامعة القاهرة. وانتقلتُ بدوري من مدرسة فاروق الأول الثانوية إلى مدرسة السعيدية. تزامَن هذا الانتقال مع دخولي مرحلة المراهقة وتغيُّر اهتماماتي ونوعية قراءاتي، فاتسعَت لقصصٍ من نوع «خذني بعاري»، وعندما أزمع مؤلِّفها عزيز أرماني تنظيم مسابقةٍ لكتاب القصة الشبان، اشتركتُ فيها بأول قصة قصيرة في حياتي. وفزت بالجائزة الثالثة، فيما أعتقد، ومقدارها ثلاثة جنيهات. كانت القصة ساذجةً للغاية تحمل عنوان «الأصل والصورة». ولم أُدرِك وقتَها أن حياتي كلَّها ستدور حول هذه المقارنة الصعبة، والمحاولة المُستمرَّة للمواءمة بين المثال والواقع.
جائزة غونكور 2025.. لوران موفينييه
عادت جائزة غونكور 2025 إلى حضنها الفرنسي بفوز الروائي الفرنسي لوران موفينييه Laurent Mauvignier عن روايته «البيت الفارغ» التي كانت هي الأخرى متوقعة نظرا لما شهدته من إقبال لدى القراء والنقاد والمتتبعين في الصحافة الثقافية الفرنسية. وكان رئيس أكاديمية غونكور، الكاتب فيليب كلوديل، نوّه، أمام الصحافة، بمجمل أعمال الكاتب وخصّ روايته الأخيرة بإشادة خاصة قائلا: «نحن نحيي كاتبًا له أعمال مهمة بالفعل، وقدم لنا هذا العام ليس مجرد عمل، بل رواية أساسية». ومن جهته عبّر لوران موفينييه، أثناء تسلمه للجائزة، عن سعادته بهذا التتويج قائلا: «أنا في غاية السعادة، إنّها مكافأة عظيمة لأنّها رواية عن طفولتي، تمتدّ جذورها عبر أجيال من العائلة والذاكرة».
ولد لوران موفينييه في مدينة تور الفرنسية سنة 1967، وحصل سنة 1991 على شهادة تخصّص في الفنون التشكيلية. صدرت له روايته الأولى «بعيدا عنهم» سنة 1999 عن منشورات «مينوي» التي صارت الناشر الرئيسي لأعماله. طبعت له ما يزيد عن ثلاث عشرة رواية نال عنها عدّة جوائز مرموقة، من أهمّها روايته «في الحشد» سنة 2006 التي استوحى فيها مأساة ملعب «هيسيل» لكرة القدم في بلجيكا، حيث انهارت تحت ضغط المتفرجين عدّة حواجز حديدية وجدار، ممّا تسبّب بوقوع تسعة وثلاثين قتيلا وأربعمائة وأربعة وخمسين جريحا، وروايته «كانوا بشرا فحسب» وروايته «البيت الفارغ» التي حاز بفضلها على جائزة الغونكور لهذه السنة. له كذلك ثلاث مسرحيات ودراسة نقدية ورحلة إلى نيودلهي وكتاب في التصوير الفوتوغرافيّ وكتاب حوارات. تميّز بكتابة مكثفة تعنى بالصوّر وبالسعي إلى التقاط الصوت الداخلي للشخوص، وصرّح في الكثير من المرّات بقربه الشديد من كتابات الأمريكي الشمالي وليام فولكنر والنمساوي توماس برنهارد.
تدور أحداث رواية «البيت الفارغ» في أحد المنازل القروية في منطقة تورين الفرنسية حيث عاش أسلاف الكاتب لأجيال متعددة. وعن طريق هذا الفضاء الثابت والأجيال المتعاقبة يتتبع لوران موفينييه تاريخ العائلة من خلال الأحداث الكبرى التي شهدتها فرنسا وأوروبا من حروب وتحولات في القرن العشرين. عن اختيارات موضوع روايته وخلفياته التاريخية والأدبية والظروف المرتبطة به يقول الكاتب: «أعتقد أن تاريخ عائلتي يشبه تاريخ ملايين الفرنسيين، بما فيه من مناطق ظلّ وجوانب أكثر مجدا»، ويضيف: «أنا أكتب وأنشر منذ خمسة وعشرين عاما ولم أعش تجربة كهذه طوال هذه السنوات.
وحتى اختيار روايتي من قبل لجنة تحكيم الغونكور في الدور الأول من عملية التصويت كان مفاجأةً بالنسبة لي لأن الروايات الثلاث الأخرى المرشحة ممتازةٌ فعلا وأنا معجبٌ بكُتّابِها. يجب أن أوضح هنا أن كتابةَ هذه الرواية كانت نوعا من العلاج النفسي وأنها أنقذتني حرفيا. ذلك أنني كنت في غاية المرض وأخضعُ للعلاج في المستشفى لشهور طويلة بعد إصابتي بمرض السرطان ومع ذلك واصلتُ الكتابة كلما سمحت لي صحتي الهشة بذلك… كان لدي انطباعٌ بأن الرواية تعرف مسارَها جيدا وتكتبُ نفسها بنفسها وهذا بحد ذاته معجزةٌ بالنسبة لي.
عندما تم الإعلان عن فوزي بالجائزة فكرت مباشرة في والدتي لأنّها الملهم الرئيسي لهذه الرواية، وهي التي سردت عليَّ معظم قصص هذه الرواية رغم أنها ليس لها حضور كشخصية في هذه الرواية. أيضا يجب أن أقر بأن الصورة التي تسكنني بقوة منذ سن الثامنة هي صورة والدي الذي شاهد بأم عينه والدتَهُ وهي تخضع بالقوة لحلق رأسها بالكامل بعد اتهامها بمخالطة الجنود الألمان بعد تحرير فرنسا من النازية عام 1945 وسنه لا يتجاوز السابعة. هذه الصورة جزء من الأشياء التي جعلتني أصير كاتبا. وأتذكر أن جدتي تعرضت لعملية محو قاسية في تاريخ عائلتي حدَّ أنه تم تشطيُب وجهها في ألبوم الصور العائلية وحتى ذِكر اسمها كان من المحرمات في الوسط العائلي».
رواية «البيت الفارغ» في مجملها، على غرار سائر أعمال لوران مونفينييه الروائية، كُتبت بمنظور طفل تغلب عليه نظرة الخوف والدهشة، وهذا ما عبّر عنه الكاتب في الكثير من حواراته: «يمكنني القول إنَّه في رواية (البيت الفارغ)، كما في الكثير من كتبي الأخرى، كنت أكتب من منظور طفل والمنزل الذي أتحدث عنه يبدو في الواقع أصغر بكثير مما هو عليه في الرواية وعندما كنت صغيرًا، كان يُقلقني أن أرى البالغين وقد نسوا تمامًا الطفل الذي كانوا عليه يومًا. لقد كنت مهووسًا بفكرة أنني عندما أكبر، يجب أن أظل على اتصال بذلك الطفل الذي كنتُه أنا أيضًا وقد وفيتُ بوعدي فالرجل الذي أنا عليه اليوم يوجه كلامه إلى ذلك الطفل كما كان الطفل في الماضي، يحدّث الرجل الذي سيصبحه وأخشى أن يمحو الرجل الذي سأكونه أثر الطفل الذي كنتُه، أن يكتسب ثقة البالغين وينسى موطن هشاشته الأولى طفولته، التي كانت أيضًا موطن بصيرته الحادّة تجاه عالم الكبار وكما ذكرت تجربتي في المستشفى في تلك السن والتي جعلت وعيي بالعالم أكثر حدةً وعمقا، ولعبت دورًا أساسيًا في نشأة رغبتي في أن أصبح كاتبًا».
إنّ الرواية كما يقول الكاتب «هي بالفعل تأمل في الفقد والذاكرة، ولقد سعى من خلالها إلى الغوص في هشاشة الروابط الإنسانية حين يثقلها التاريخ والحروب، وإلى مساءلة ما تبقى فيها بعد الخراب، فهذا البيت ليس مجرد مكان لعائلة بل مرآة لأوروبا التي خرجت من الحربين مثقلة بالصمت، ولأجيالٍ حاولت أن تواصل العيش رغم الفقد الطويل وكل ما أرادت هي أن أجعل من المأساة العائلية استعارة لزمنٍ خسر بيوته، ولم يجد سوى الذاكرة ملجأ يحتضنه».
ماريو فارغاس يوسا.. رحيل آخر كبار أدباء أمريكا اللاتينية
كان رحيل ماريو فارغاس يوسا Mario Vargas Llosa بمثابة نهاية حقبة ذهبية من التاريخ الأدبي لأمريكا اللاتينية، شهدت أمجادها وتأثيرها العظيم على الأدب العالمي برمّته. شكّل رحيل يوسا نوعا من الاستثناء الفريد ميّزته كتاباته وشخصيته عن باقي كتّاب قارة أمريكا اللاتينية سواء في اختياراته الأدبية أو السياسية، ذهبت به إلى حدّ الترشّح لرئاسة بلاده وأن يبوء مسعاه بالكثير من الخيبة والخذلان، وأن يتقلب في اختياراته السياسية دون أن يتخلّى عن إخلاصه التّام للكتابة والأدب.
كان حصول يوسا على جائزة «نوبل» سنة 2010، بعد غريمه غابريال غارسيا ماركيز، تزكية قوية للأدب والرواية تحديدا في أمريكا اللاتينية من خلال تنويهها بمجمل أعماله التي لخصتها في كونها: «ترسم خريطة لهيكليات السلطة» و«لتصويرها المرهف لمقاومة الفرد وتمرّده وفشله» خاصة في أشهر أعماله الروائية «مدينة الكلاب» و«حفلة التيس» و«البيت الأخضر» أو «حوار في الكاتدرائية»… أو الاحتفاء بالجسد وتجلياته في «امتداح الخالة» و«دفاتر دون ريغوبرتو». كانت هذه المرحلة التي رسم ملامحها القوية يوسا بقوله: «اكتشف فيها العالم أدب أمريكا اللاتينية، الذي كان موجودا منذ فترة طويلة ولكنّه كان حبيسا. لم يغادر أمريكا اللاتينية».
يتحدث يوسا، في كتابه «الكاتب وواقعه»، عن تأثير بورخيس في مساره الروائي: «كنتُ معجبا بجان بول سارتر عندما كنتُ طالبا، واعتقدتُ بشدّة في نظريته القائلة بأنّ التزام الكاتب التزام تجاه زمنه ومجتمعه الذي يعيش فيه. إنّ الكلمات أفعال، وإنّه يمكن للإنسان من خلال الكتابة أن يؤثر في التاريخ. الآن تبدو هذه الأفكار ساذجة، وربّما باعثة على التثاؤب. فنحن نعيش في عصر من التشكك الواثق في قوّة الأدب كما في قوة التاريخ. لكن في الخمسينيات كانت فكرة أنّ العالم يمكن أن يتغيّر للأحسن وأنّ الأدب يجب أن يساهم في هذا المجهود فتنت العديد منّا كفكرة مثيرة ومقنعة. في هذا الوقت كان تأثير بورخيس بدأ يصبح ملموسا لأبعد من الدائرة الضيقة لمجلة Sur ومعجبيه الأرجنتينيين. ففي عدد من المدن الأمريكية، بين اللاتينيين وجماعات المهتمين بالأدب كان الأتباع المتحمسون يتقاتلون على أندر نسخ من كتبه كما لو كانت كنوزا، وحفظوا عن ظهر قلب كلّ هذه القوائم العشوائية الخيالية أو الكتالوغات التي ترصّع صفحات بورخيس، مثل تلك الجميلة بشكل خاص من مجموعة «الألف» ونهلوا ليس فقط من متاهاته ونموره ومراياه وأقنعته وسكاكينه، لكن أيضا من استخدامه المذهل الجديد للصفات والأحوال…
كان بورخيس يمثل، بشكل تحليلي واضح، كلّ ما علّمني سارتر أن أكره: الفنان الذي ينكمش من العالم حوله ويلجأ لعالم من العقل، المعرفة والخيال، كاتب ينظر باحتقار للسياسة والتاريخ، بل وحتّى الواقع، ويعرضُ تشككه بلا خجل، وازدراءه العنيد لأيّ شيء ينبع من الكتب. المثقف الذي لم يسمح لنفسه فقط أن يتعامل بسخرية من العقائد والمثالية اليسارية، لكن أيضا يمدّ ولعه بتحطيم الأصنام إلى الحدّ المتطرف المتمثل في الانضمام للحزب المحافظ، ويبرر بعجرفة قراره بأن يُعلن أن الجنتلمان يفضّل القضايا الخاسرة». ويضيف أخيرا: «أعتقدُ أيضا أنّ الدّين الذي ندينُ به نحن الذين نكتبُ بالإسبانية لبورخيس دين عظيم».
أجمل قصّة في تاريخ الفلسفة
يمهّد الكاتب والفيلسوف الفرنسي لوك فيري لكتابه (أجمل قصة في تاريخ الفلسفة) بقوله: «تولّد الفلسفة اهتماما متزايدا، وربّما الأمل في تقديم معنى لوجودنا، وذلك في عالم متأزّم حيث ينتشر منطق المنافسة على نحو أعمى. فالرغبة في الإفلات من هذا الإحساس بضياع مصيرنا من أيدينا تتعاظم بقدر ما أنّ المُثل التقليدية والسيّر الكبرى (الروحية والدينية والوطنية أو الثورية) التي كانت تُستلهم لتوجيه حياتنا افتقدت على نحو واسع قوّتها في الإقناع حيال واقع لم يعُد لها تقريبا أيّ نفوذ عليه. ولم يبق لنا من اختيار سوى البحث عن سبيل للنجاة، اللهم إلّا إذا انسقنا مكتفين بنوع من الغيظ المتّسم بالحنين. ما الذي يجعل الحياة في أعيننا تستحق أن تُعاش ونتمسّك بها رغم معرفتنا بقصرها وخاتمتها؟ وما الذي يجعلنا، أيضا، على استعداد للموت باندفاع من أجل مُثل أو اعتقادات؟
في سياق البحث عن أجوبة يبرز من جديد الاهتمام بالفكر الفلسفي. فما الفلسفة؟ وماذا ننتظر منها؟ ألا نزال في حاجة إليها؟ وبماذا يمكن أن تساعدنا في عصر تبدو فيه المنزلة الإنسانية خاضعة لتوسّع هيمنة الابتكارات التكنولوجية؟ لكنّ الاكتشافات العلمية والإصلاحات السياسية والإبداعات التقنية لا تُخبرنا، مهما تكن خصبة، أيّ ضرب من الحقيقة نستطيع بلوغه، ولا تُعزّز أو تمنح مشروعية لقيمنا الأخلاقية. بل لا تروي تعطّشنا إلى الظفر بإجابة عن تساؤلاتنا عن كيف تكون حياتنا، حياة طيبة لنا نحن البشر الفانين، حياة كفيلة بإنقاذ وجودنا من السّخف الذي يتهددنا. الإجابة عن هذا التحدّي بالوسائل الإنسانية الصّرفة التي يوفّرها التفكير العقلي إنّما هو تحديدا موضوع الفلسفة القصوى.
يتطرق المؤلف إلى تعدد موضوعات الفلسفة كالتالي: «تنقسم الفلسفة، بكلّ بداهة، إلى مجالات متعددة: (ما الحقيقة؟)، الأخلاق والسياسة (ما العدل؟)، مسألة معايير الجمال، وأخيرا مسألة الخلاص (ما الحياة الطيّبة؟). ولا أنسى أنّ الفلسفة تهتم أيضا، وحتّى في البداية، بما يجعل المعرفة الموضوعية ممكنة، وبالتفكير النقدي في تعريف ما هو عادل، وبالنظرية السياسية أو بمنابع الإحساس الجمالي. ولا أنسى كذلك أنّ بعض الفلاسفة، الذين تركوا بلا منازع بصماتهم في تاريخ الأفكار، لم ينكبّوا إلّا على البعض من هذه الموضوعات، بل إنّهم لم يعالجوا إلّا موضوعا واحدا. وعلى سبيل المثال، يكاد ميكيافيللي يقصر اهتمامه على الحياة السياسية دون سواها، في حين لا يعترض أحد على أنّه ينتمي تماما إلى تاريخ الفلسفة».
أعطى الكاتب نموذجا من أجمل قصة في تاريخ الفلسفة في (الصفحة البيضاء) أو حلم ديكارت: «هكذا يبادر ديكارت بإنجاز الفعل الثوري الشهير، المتمثل في (الصفحة البيضاء)، إذ استبعد كلّ ما هو آتٍ من الماضي وجميع الأحكام المسبقة، منتهيا إلى وضع وجود العالم الخارج عن وعيه موضع شك. إنّها حجة الحلم الشهيرة: فقد حدث له في المنام أن اعتقد أنّه في حالة يقظة وأنّه بصدد الكتابة، بينما كان، على حدّ قوله، (عاريا تمام العراء في سريري). وإذن ليس من المحال أن لا تكون حياة اليقظة سوى حالة أخرى تُوهمنا بوجود واقع خارجي. ومرّة أخرى، نقول إنّ مشروع ديكارت هو الخروج من هذا الارتياب العام، بالكشف عن حدس حقيقة لا نزاع فيها بواسطة قدرات العقل البشري وحدها، فقد كتب في مقالة في المنهج يقول: (كنتُ أتصوّر أنّه ينبغي عليّ استبعاد كلّ ما أستطيع أن أتخيّل فيه أدنى شكّ، باعتباره كاذبا على الإطلاق، وذلك حتّى أرى إن بقي بعد ذلك شيء في اعتقادي يكون تماما غير قابل للشك). اندفع ديكارت في مغامرة فكرية خارقة، وأظهر جرأة لا تُصدّق، إن لم نقل إقداما عجيبا من خلال الإطاحة بإرث الحضارة السابقة كي يعثر على يقين مطلق بواسطة (الحسّ السليم) وحده، الذي يشدد على أنّه تحديدا (أعدل الأشياء توزّعا) بين الناس».
الأدب في خطر
كان الناقد والمفكر تزفيتان تودوروف Tzvetan Todorov أطلق تحذيرا قويا، من خلال عنوان كتابه «الأدب في خطر»، موجّها إلى الأوساط الأدبية والرأي العام الفرنسي، مبرزا الوضع الخطير الذي آل إليه الأدب في بلد الأنوار. فهو لا يستشعر الخطورة في عزوف القراء عن متابعة الأعمال الأدب والإقبال عليها ولا في المنافسة الشديدة للأدب من قبل الإنترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي، ولكن بالتحديد إلى ما كرسته المناهج التعليمية والمقررات الدراسية الوفية لمدارس النقد المعاصرة التي يطغى عليها الاهتمام المبالغ فيه بالجانب الشكلي على حساب مكونات من العمل الأدبي أدى إلى فقدان الأدب روحه وقيمه الجمالية والإنسانية وعزله بالتالي عن الواقع والعالم.
وكم كان تودوروف متواضعا ومنصفا حين وصف وضع النقاد إزاء الأدباء المبدعين بالأقزام الذين يحاولون اعتلاء أكتاف العمالقة، مظهرا بذلك مدى أهمية الأدب في حياة الأمم والشعوب. وإذا كان هذا النقد الذاتي، الذي وجهه تودوروف إلى النقاد، لم يثن البعض منهم عن انتقاد تودوروف نفسه لمساهمته في تكريس التوجه الشكلاني والبنيوي الذي هيمن على النقد الفرنسي الحديث، وأنّه كان مشاركا مشاركة فعّالة في اللجان التي وضعت البرامج والمقررات الدراسية للأدب في المؤسسات التعليمية، وبالتالي يتحمّل المسؤولية الأخلاقية الكاملة للوضعية الخطيرة للأدب في فرنسا. لكن كتاب «الأدب في خطر» لم يكن فقط اعتراف الكاتب بالندم بقدر ما كان محاولة دق جرس الإنذار لوضع الأدب والأدباء في هذا العصر. لذلك دعاه هذا الاقتناع إلى الإقرار بأهمية الأدب وجدواه بقوله: «الأدب، مثلما الفلسفة، مثلما العلوم الإنسانية، هو فكر ومعرفة للعالم النفسي والاجتماعي، الذي نسكنه، والواقع الذي يطمح الأدب إلى فهمه هو، بكل بساطة (لكن، في الآن ذاته، لا شيء أكثر تعقيدا)… التجربة الإنسانية.
لذا يمكن القول إنّ دانتي أو سرفنتيس يُعلماننا عن الوضع البشري على الأقل مثلما يعلمنا أكبر علماء الاجتماع وعلماء النفس، وأنّه لا تعارض بين المعرفة الأولى والثانية. ذلك هو «الجنس المشترك» للأدب…» كما يعبّر، في أحد فصول كتابه «اختزال عبثي للأدب»، عن استشعاره لخطورة وضعية الأدب في فرنسا: «بمرور الزمن، اكتشفتُ بشيء من الدهشة أنّ الدور الرفيع الذي كنتُ أسنده إلى الأدب لم يكن الجميع يعترف به، أوّل ما أثارني هذا التباين كان في التعليم المدرسي. لم أدرّس في ثانوية بفرنسا، ولا في الجامعة إلّا قليلا. غير أنّي، وقد صرتُ أبا، ما عاد بمقدوري البقاء عديم الإحساس بنداءات الغوث التي يبعث بها أطفالي عشية الاختبارات أو تسليم الفروض. والحال أنّي، حتّى لو لم أجعل في ذلك كلّ طموحي، بدأتُ أشعر بشيء من التكدّر وأنا أرى إرشاداتي أو تدخلاتي تنتج عنها درجات تميل إلى ما دون المتوسط! في ما بعد، اكتسبتُ رؤية شاملة للتعليم الأدبي في المدارس الفرنسية، بمشاركتي ما بين 1994 و2004 ضمن المجلس الوطني للبرامج، في لجنة استشارية متعددة الاختصاصات، تابعة لوزارة التربية الوطنية. هناك فهمت: إنّ فكرة عن الأدب مغايرة تماما توجد في الأصل ليس فحسب من ممارسة بعض الأساتذة المنعزلين، بل أيضا من نظرية هذا التعليم والتعليمات الرسمية المؤطّرة له».
التخييل التاريخي في الرواية العربية المعاصرة
صدر، عن دار خطوط وظلال بالأردن، كتاب «التخييل التاريخي في الرواية العربية المعاصرة (تفكيك النسق وتمثيل الأسئلة المضمرة)» في طبعته الثانية للكاتب والناقد المغربي سعيد الفلاق.
يوضّح المؤلف أبعاد الكتاب: «يثير الكتاب النقاش حول رواية التخييل التاريخي، وهو المصطلح الذي أطلقناه على الكتابات التخييلية التي تعيد تأليف التاريخ وتحبيكه سرديا، إذ إن التخييل هنا بصفته استراتيجية كتابية لا يتجه إلى الواقع بالدرجة الأولى، وإنما إلى الماضي لاستعادة قصة معينة وإعادة تقديمها. لسنا أمام رواية تاريخية بمفهوم جُرجي زيدان الذي يرى أن الرواية خدمٌ للتاريخ، وحيلة من الحيل لتبليغه إلى الناشئة، لكننا أمام رواية التخييل التاريخي التي تفسح المجال للخيال أكثر من أن تنظر إلى الوقائع أو الحقائق، لأن مهمة التأريخ توكل إلى المؤرخ لا إلى الروائي، ومتى ما حاول الروائي التأريخ تجاوز فن الرواية».
في كلمة الغلاف بقلم الناقد المغربي سعيد يقطين نقرأ: «يبدو لي من خلال الاطلاع على كتاب (التخييل التاريخي) أن سعيد الفلاق يمتلك طاقة متفرّدة، وسعة أفق، وطموحا يمكنه من مواصلة البحث والتنقيب، والبحث عن ذاته المتفردة في خضم ما يروج في مجال الدراسات الأدبية المغربية والعربية. يبدو لنا ذلك بجلاء في انتقائه للعنوان الأساسي لكتابه هذا. لقد جعله حول «التخييل التاريخي»، ووضّح من خلال العنوان الفرعي الذي يومئ إلى «تفكيك النسق»، وتمثيل «الأسئلة المضمرة». وبذلك فإنه يختار عن وعي المنحى الذي يختطّه النقد الثقافي في معالجة الرواية كما هو سائد في النقد العربي المعاصر.
ورغم عدم اتفاقي مع هذا التوجه في دراسة السرد الروائي لأسباب نظرية ومنهجية، تتصل باشتغالي بالسرديات، فإني أرى أن عمل الفلاق يكشف عن استعداد بيّن للتطور والارتقاء إلى مستوى أعلى يجعله يحتل مكانة متميزة في مجال الدراسات الأدبية العربية إذا ما واصل اجتهاداته، ومطالعاته للأصول النظرية، وبحثه الدائب عما يتميز به عن غيره. وعندي اليقين أنه شق طريقه، وسيواصل المسير بذكاء الباحث، وحرص المشتغل على المواكبة الدائمة لما يصدر من إبداعات، وما يتحقق من إنجازات نظرية وتطبيقية، والتطوير المستمر لأدواته وتصوراته».
جائزة نجيب محفوظ 2025
أعلنت وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة في مصر عن أسماء الفائزين بجائزة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لسنة 2025. وتعدّ جائزة نجيب محفوظ للرواية من أبرز المسابقات الأدبية على مستوى العالم العربي التي تهدف إلى دعم الإبداع الروائي في مصر والعالم العربي وإبراز الأعمال الروائية المتميّزة بتعبيرها عن القضايا الإنسانية والمنفتحة على الآفاق العالمية.
جائزة أفضل رواية مصرية كانت من نصيب الكاتب الروائي شريف سعيد عن روايته «عسل السنيورة» الصادرة عن دار الشروق، وأفضل رواية عربية للكاتبة الروائية اليمنية نادية الكوكباني عن روايتها «هذه ليست حكاية عبده سعيد» الصادرة عن دار الحوار.
ونوهت لجنة التحكيم برواية «عسل السنيورة» للروائي المصري شريف سعيد بقولها: «إنّ رواية «عسل السنيورة» تتمتع بقيمة أدبية وفنية عالية، وطرح إنساني عميق وقدرة على بناء شخصيات نابضة بالحياة». وعن رواية «هذه ليست حكاية عبده سعيد»، للروائية اليمنية نادية الكوكباني، قالت لجنة التحكيم: «تتمتّع الرواية بأسلوب سردي متماسك، يمزج بين البعد الاجتماعي والبعد الرمزي في معالجة القضايا المطروحة».
وسبق أن حصل على الجائزة، في دوراتها السابقة، عدد من أبرز المبدعين العرب، من بينهم الكاتبة المصرية ريم بسيوني، والكاتب الموريتاني محمد فاضل الشهير بـ«محمد عبد اللطيف»، والروائي المصري علاء أحمد فرغلي، والروائي السوري سومر شحادة، والكاتب الروائي إبراهيم فرغلي والروائي الفلسطيني حسن حميد بن أحمد.